مهمة مجدد القرن الرابع عشر
قال الإمام المهدي والمسيح الموعود ميرزا غلام أحمد عليه السلام: إن فتنة النصارى هي أُمُّ الفتن، ولذلك قيل إن مهمة مجدد القرن الرابع عشر أنه “يكسر الصليب.” وبسبب انطباق هذه العلامة على مجدد القرن الرابع عشر سُِّمي مسيحا موعودا، لأن الثابت من الأحاديث أن مهمة المسيح الموعود أنه يكسر الصليب. ومعارضونا لا يسعهم إنكار أن واجب مجدد القرن الرابع عشر أن يكسر الصليب لأن هذه هي المصيبة التي واجهها، فكيف يسعهم إنكار أن المسيح الموعود هو مجدد القرن الرابع عشر؟ إننا نعتني بالعطاشى للحق، أما الذين لا يبحثون عن الحق ويملكون طبائع غير مستقيمة فأنى لهم أن ينتفعوا منا؟ اعلموا أن الهدى يكون في نصيب غير المتعصبين، أما الذين لا يتدبرون فلا ينتفعون شيئا.
ليفهم طالب الهدى أن مهمة مجدد القرن الرابع في الظروف الراهنة أن يكسر الصليب، لأن الفتنة الصليبية منتشرة انتشارا مخيفا. إن الإسلام دين كان إذا ارتد عنه شخص واحد في الماضي قامت القيامة، أما اليوم فإن عدد المرتدين عنه قد بلغ مئات الآلاف للأسف الشديد، والمولودون في بيوت المسلمين يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم -ذلك الإنسان الكامل الذي لا نظير له في طهارة الباطن- بأنواع التهم التي تدمي القلوب. لقد نشرت هذه الفئة ملايين الكتب في تكذيب سيد المعصومين، وتشيع دوريات كثيرة من جرائد ومجلات أسبوعية وشهرية للغرض نفسه. أفلم يكن خليقًا بالله تعالى أن يبعث مجدِّدا في هذا الوضع؟ ثم بيِّنوا بالله بعد التفكير أنه لو بُعث المجدد في هذا الوقت فهل كان عليه أن يهتم بالجدالات الدائرة حول رفع اليدين والجهر ب “آمين”؟ فكِّروا مليًّا هل من واجب الطبيب أن يهتم بعلاج الوباء المتفشّي بين الناس أم يهتم بمرض آخر. لقد بلغت إهانة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتهى في هذا العصر. ورد أن صحابيا سمع أُمَّه تهين النبي صلى الله عليه وسلم فقتلَها. هكذا كانت غيرة المسلمين وحميتهم، أما اليوم فإنهم يقرأون ويسمعون كتبًا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا تأخذهم الغيرة. بل لا يأنفونها ولا يكرهونها، وإنما يعادون الذي قد بعثه الله تعالى للقضاء على هذه الفتنة خاصة، وقد جاء متحليًا بغيرة عظيمة لإرساء عزة النبي صلى الله عليه وسلم وجلاله، ويسخرون منه ويستهزئون. نسأل الله أن يهبهم عين البصيرة. آمين
نبوءة عظيمة عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم
قال الإمام المهدي والمسيح الموعود ميرزا غلام أحمد عليه السلام: لقد كشف الله تعالى سموّ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة مكانته بإنزال سورة في القرآن الكريم، ألا وهي: “أَلَْم تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَِأصْحَابِ الْفِيلِ” (الفيل:1). لقد نزلت هذه السورة وسيد الكون صلى الله عليه وسلم هدفٌ للمحن والآلام، فطمأَنَه الله تعالى في تلك الحالة وقال إني مؤيدك وناصرك. وفي قوله تعالى: “أَلَْم تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَِأصْحَابِ الْفِيلِ” (الفيل:1)، نبوءة عظية، وكأنه تعالى قال له ألم تر أن ربك ردَّ مكرهم في نحورهم وأرسل طيورًا صغارًا لإبادتهم. لم تحمل تلك الطيور بنادق، بل حملت الطين فقط، لأن “السجيل” هو الطين. قد عدَّ الله في هذه السورة رسولَه صلى الله عليه وسلم الكعبةَ، وأنبأ بنجاحه وتأييده ونصرته بذكر حادث أصحاب الفيل، بمعنى أنّ الذين يسعون ويكيدون لإفشال مهمة النبي وأعماله كليةً، سوف يردّ الله تعالى مكايدهم وجهودهم في نحورهم بإهلاكهم بدون أسباب كبيرة، كما دَمّرت العصافيُر أصحابَ الفيل. وهذه النبوءة ممتدة إلى يوم القيامة، فكلما أطلَّت فئةٌ برأسها كأصحاب الفيل هيأ الله تعالى مِن عنده الأسباب لتدميرهم ولإحباط مكايدهم. هذه هي سياسة القسيسين. إن الإسلام هو الصخرة الجاثمة على صدورهم، أما الأديان الأخرى فهي كالخناثى عندهم. والهندوس أيضا إذا تنصّروا ألّفوا الكتب ضد الإسلام فقط. لقد بذل “رام شندر” و”تهاكر داس” كل ما في وسعهما لتأليف الكتب ضد الإسلام، ذلك لأن ضمائرهم تقول لهم أن هلاكهم على يد الإسلام وحده. ومن الطبيعي أن المرء إنما يخاف مما يسبّب هلاكه. الفراخ مثلًا تبدأ بالصراخ فورا برؤية القط، كذلك فإن الجهود التي يبذلها أتباع شتى الأديان عموما والقساوسة خصوصا ضد الإسلام إنما سببها أن قلوبهم تستيقن وضمائرهم تشهدهم أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي سيسحق مِللهم الباطلة.
الدفاع عن الإسلام
إن الإسلام اليوم هدف لغارة كغارة أصحاب الفيل، والمسلمون مصابون بأنواع الضعف، والإسلام فقير غريب وأصحاب الفيل أقوياء. ولكن الله تعالى يريد أن يُري المشهد نفسه ثانية، ويسخِّر العصافير للقيام بتلك المهمة نفسها. فما جماعتنا وما حقيقتها إزاءهم؟ إنها لا تساوي إزاءهم شيئًا، وهي ليست أمام اتحادهم وقوتهم وثروتهم شيئًا يُذكَر، ومع ذلك نرى حادث أصحاب الفيل أمام أعيننا، فكم تبعث على الاطمئنان هذه الآيات التي أنزلها الله تعالى!
لقد تلقيتُ أنا أيضا هذه الآية بالوحي، مما يبين جليا أن تأييد الله ونصرته ستعمل عملها حتمًا، ولكن لا يوقن بذلك إلا الذين يحبون القرآن الكريم، أما الذي ليس في قلبه حب القرآن ووداده، فأنّى له أن يأبه بهذه الأمور؟ إنما الإسلام والإيمان أن يوافق المرء أمر الله تعالى. إن الذي لا يعزّ الإسلام ولا يغار عليه، فلا يعزّه الله ولا يغار عليه، أيا كان، وهو ليس بمسلم في الواقع. لا تحتقروا أقوال الله تعالى، وارحموا الذين كفروا بالحق تعصبًا وقالوا لا حاجة لبعثة أحد في عصر الأمن والسلام هذا. واأسفا عليهم، أفلا يرون كيف أحدق الأعداء بالإسلام من كل حدَب وصوب، وكيف صار هدفًا لهجمات تلو الهجمات، وكيف يساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون أنْ لا حاجة لبعثة أحد.
قانون قمع الفتن
إن قانونَ قمع الفتن والتمرد الصادرَ من قبل الحكومة خيٌر لنا، ولن ينتفع منه إلا نحن، وسيكون سبابا لإهلاك الملل الأخرى، إذ نملك كنوز الحقائق والمعارف، وسنواصل توزيعها بلا نهاية. ما هي المعارف التي يمكن أن يعرضها الآريون الهندوس والقسس على الناس؟ وماذا أرى منها القسيسون خلال نصف القرن الماضي؟ متى يقدرون على تقديم شيء غير الشتائم والسباب حتى يقدموا شيئا آخر في المستقبل؟ وليس بأيدي الهندوس أيضا إلا المطاعن. وها نحن نتحدى أنه لو ادعى أيُّ آري أو قسيس بيانَ محاسن دينه ومزاياه فلن يقف أمامنا ساعة واحدة.
(جريدة الحكم، بتاريخ 17-7-1901م)
عقيدة الفداء
إن أول لبِنة للدين هي معرفة الله تعالى، فما لم تكن هذه المعرفة سليمة فكيف تكون الأعمال طاهرة؟ يعترض النصارى كثيرا على طهارة الآخرين الباطنة بسبب إيمانهم بعقيدة الفداء المنافية للأخلاق. لا أفهم كيف يمكن للإنسان أن يخاف مؤاخذة الله مع إيمانه بعقيدة الفداء. أليس صحيحا أنهم يؤمنون أن كل الوبال وقع على المسيح جراء ذنوبهم، حتى عُدَّ ملعونًا وبقيَ في الهاوية ثلاثة أيام. ولو عوقب الناس على آثامهم بعد ذلك فما فائدة الكفارة والفداء إذن؟ إن عقيدة الكفارة والفداء تقتضي ارتكاب الإثم. لا جرم أن المبادئ والعقائد لها تأثير كبير. فالبقرة مثلا مقدسة ومعظمة جدا عند الهندوس، ومن تأثير عقيدتهم هذه أنهم اعتقدوا بطهارة بولها وروثها أيضا، وتجاوز حماسهم لتقديسها الحدود كلها. وليس ذلك إلا لأن هذا التقديس رسخ فيهم كعقيدة ومبدأ. اعلموا أن المبادئ هي بمنزلة الأم، والأعمال بمنزلة الأولاد. ما دام المسيح قد صار فداء وحمل آثام المؤمنين كلها، فلماذا لا تُرتكب الآثام إذن؟! الغريب أن المسيحيين حين يشرحون عقيدة الكفارة والفداء يبدأون خطابهم بالحديث عن رحمة الله وعدله، ولكني أسأل: لو صُلب زيد مكان بكر فأين العدل والرحم في ذلك؟ ما داموا يؤمنون أن المسيح قد حمل الذنوب كلها فأي مانع يمنع الناس من ارتكاب الإثم؟ لو قالوا إن المسيح صار كفارة عن ذنوب النصارى الموجودين في ذلك الوقت لكان أمرا آخر، ولكنهم ما داموا يؤمنون أن المسيح حمل كومة ذنوب الآثمين كلهم إلى يوم القيامة وقد نال عقابها أيضا، فإن مؤاخذة الآثم بعد ذلك ظلمٌ ما بعده ظلم. أن يعاقَب البريء مكان الآثم هو في حد ذاته ظلمٌ، والظلم الثاني أن يُحمَّل المسيح كومةَ آثام الآثمين ويبشَّروا أنه قد حمل عنهم آثامهم، ومع ذلك يؤاخَذون على آثامهم ثانية. إنها خدعة غريبة لا يستطيع المسيحيون الرد عليها.
عقيدة الفداء تجريء على المعاصي
ولو قيل إن الإيمان بالفداء ينجي صاحبه من حياة الإثم فلا يعود قادرًا على ارتكابه، فهذا ادعاء لا دليل عليه. ذلك أن مبدأ الفداء هذا إثم في حد ذاته. الحق أن القدرة على تجنب الإثم تتأتى بخوف مؤاخذة الله، ولكن ذلك الخوف لا يتأتى لمن يؤمن بأن المسيح قد حمل عنا ذنوبنا، والنتيجة أن حامل هذا المبدأ لا يكون تقيا أبدا، لأنه لن يرى كل ما هو مبني على التقوى ضروريا. اعلموا جيدا أن الطهارة الباطنية تبدأ بالمبادئ السليمة دوما، وإلا فقد قيل:
![]()
أي: لا يُعلَم خبث النفس لسنواتٍ وسنوات.
ثم علينا أن نرى ما هي النماذج العَملية التي قدمها المؤمنون بعقيدة الفداء للطهارة الباطنية. إن سوء أعمال أوروبا معلوم للجميع. في أوروبا تُشرب الخمر التي هي أم الخبائث بكثرة لا نظير لها في أي بلد في العالم. لقد قرأت في جريدة أن محلات الخمر الكائنة في لندن لو وُضعت في صف واحد لبلغ 75 ميلا. فما دام هؤلاء يعلمون أنهم قد أُعطوا الترخيص لكل معصية؛ وأن أحدهم مهما ارتكب من الآثام فهي مغفورة له، فماذا يكون التأثير لهذا التعليم؟ يجب أن يجيبنا المسيحيون بعد تفكيٍر وتأنٍّ .
لو كان هذا هو مبدأنا- معاذ الله – فكم كان التأثير سلبيًا علينا. إن النفس الأمارة إنما تبحث عن المبررات. انظروا كيف لجأ الشيعة إلى الاتّكال على إغاثة الإمام الحسين رضي الله عنه، وظنوا أنهم مهما فعلوا لاجئين إلى التقية فلا بأسَ عليهم. وأقول دون أدنى خوف أنكم ستجدون بين الشيعة قلة قليلة من الأتقياء بسبب تمسكهم بمبدأ التقية وعقيدة فداءِ الإمام الحسين رضي الله عنه لقد كتب خليفة محمد حسين الشيعي أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: “وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ” (الصافات:107) يشير إلى استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه، وقد فرح هذا الشيعي جدا بقوله هذا ظنًا منه أنه أدرك لُبَّ القرآن الكريم، واطّلع على نقطة معرفة عظيمة. وهذا يذكّرني بحكاية سكران.كان عند سكران إبريق مثقوب، وكلما ذهب لقضاء حاجته أخذ معه الإبريق للاستنجاء، وكان الإبريق يفرغ من الماء قبل فراغه من حاجته. فظل يفكر أياما لحل المشكلة حتى اهتدى إلى حيلة بارعة في زعمه، حيث قرر الاستنجاء بماء الإبريق قبل قضاء الحاجة، وفرح بذلك فرحة كبيرة. فالاستنتاج الذي قام به السيد خليفة محمد حسين من قول الله تعالى: “وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ” (الصافات:107) يماثل حيلة هذا السكران البارعة. لا يستطيع الشيعة الحفاظ على نظافة مساجدهم أيضا. كنت أدرُس على يد معلِّم شيعي في مسجد لهم، فرأيت الكلاب تأتي وتبول وتتغوط فيه، ولا أتذكر أن أحدًا صلى فيه قط. يقول الشيعة إن الإمام الحسين وأهل البيت قد استُشهدوا من أجلنا، ويكفينا لدخول الجنة أن نبكي ونندب حزنًا عليهم دون أي حاجة بنا إلى أي عمل. وكذلك يقول النصارى إن دم المسيح تسبّبَ في نجاتنا. ونحن نقول لهم: ما دمتم ستُسأَلون عن ذنوبكم وتُعاقَبون عليها، فأين النجاة؟
الحق أن هذا المبدأ المسيحي سيئُ التأثير جدا، ولولاه لما انتشر الفسق والفجور في أوروبا على هذا النطاق الواسع ولَمَا جَرَفَهم سيل الفحشاء كما جرفهم اليوم. اذهبوا إلى لندن وباريس وانظروا ما يحدث في فنادقها ومتنزهاتها، واسألوا الذين يعودون من هنالك. تُنشَر كل يوم في الجرائد قوائم الأطفال الذين يولَدون ولادةً غير مشروعة.
عقيدة الفداء منافية لنواميس الطبيعة
لذا فلن ننظر إلا إلى المبادئ نفسها. أما مبدأنا فهو: “مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ” (الزلزلة:7)، ويمكنكم تقدير مدى تأثير هذا المبدأ، وهو أن الإنسان سيدرك ضرورة العمل، وسوف يسعى لفعل الخيرات. أما المبدأ الذي يقول إن نجاة المرء بالأعمال محال فهو سيجعل الإنسان قليلَ الهمة قليل السعي، فاقد الأمل وعاطلا لا يُحرك ساكنا. وهذا يكشف أيضا أن مبدأ الفداء والكفارة يمثّل إساءة إلى الكفاءات الإنسانية أيضا، ذلك أن الله تعالى قد جعل في قُوى الإنسان خاصية التطور والارتقاء، ولكن عقيدة الفداء تعيق تطور الإنسان.
لقد قلت آنفا إن التحرُّر والإباحية التي نراها عند هؤلاء المؤمنين بعقيدة الفداء هذه، إنما هو نتيجة هذه العقيدة نفسها، حيث يرتكبون الفواحش كالكلاب والكلبات، وتُرتكب الفواحش في متنزه “هايد بارك” بلندن علنًا، ويولد الأولاد ولادة غير مشروعة. لذا فعلينا ألا نكتفي بالقيل والقال، بل لا بد لنا من الأعمال. الذي لا يدرك ضرورة العمل هو قليل البصيرة وجاهل جدا. إن نظائر الأعمال ونتائجها ملموسة في قانون الطبيعة، ولكن لا نجد فيها أية نظائر لعقيدة الفداء. وعلى سبيل المثال، عندما يجوع المرء فيأكل يزول جوعه، أو حين يظمأ فيشرب الماء يزول ظمأه، وندرك من ذلك أن نتيجة أكل الطعام زوالُ الجوع، وأن نتيجة شرب الماء زوالُ العطش، ولكن لا يحدث أبدًا أن يجوع زيد، ويأكل بكرٌ، فيزول جوعُ زيد. لو وُجد نظير لذلك في قانون الطبيعة فلربما كان هناك مجال لقبول مبدأ الفداء، ولكن ما دام لا يوجد في قانون الطبيعة نظير لمبدأ الفداء فكيف يقبله الإنسان المعتاد على قبول الشيء برؤية نظيره ومثاله؟
ثم لا نجد لمبدأ الفداء نظيًرا حتى في القانون العام للبشر، إذ لم نر أن يقتل زيد بكرًا، فيفنى خالد باختصار إن الفداء مبدأ يفتقر إلى نظير البتة.
الحاجة إلى الأعمال الصالحة والتقوى
أقول لجماعتي: هناك حاجة للأعمال الصالحة. إن كان هناك شيء يمكن أن يصل إلى الله تعالى فإنما هي الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: “إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ” (فاطر:11) إن أقلامنا اليوم هي كأسياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لن يُكتب الفتح والنصر إلا للشخص التقي، فهناك وعد من الله تعالى: “كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيَن” (الروم:47)، “وَلَنْ يَْجعَلَ اُلله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا” (النساء:141). فاعلموا أن نصركم منوط بالتقوى. لم يكن العرب إلا خطباء وشعراء فحسب، ولكنهم لما تحلّوا بالتقوى، أنزل الله ملائكته لنصرتهم. لو درس المرء التاريخ لتبين له أن كل الانتصارات التي حققها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين لم تكن نتيجة القوى البشرية والجهود الإنسانية. لقد صارت الدولة الإسلامية عالمية خلال 30 عاما، أي حتى عهد خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه فهل كان هذا بوسع البشر يا ترى؟كلا، ومِن أجل ذلك قال الله تعالى مرارا: “إِنَّ اَلله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحسِنُونَ” (النحل:128).
المتقي والمحسن
والمتقي هو الخائف الحذر. هناك أمران: تركُ الشر، وإفاضة الخير، والمتقي هو مَن يترك الشر، والمحسن هو من يفيض الخير. لقد قرأت حكاية بصدد هذا الموضوع وهي أن أحد الصالحين دعا شيخًا للطعام، وقام بكل ما في وسعه لأداء حق إكرام الضيف، ولما فرغ الضيف من الطعام قال له الرجل الصالح في تواضع جم: إني آسف أني لم أتمكن من خدمتك كما ينبغي. فقال الضيف: إنك لم تحسن إلَّي بشيء، بل أنا الذي قد أحسنتُ إليك، إذ لو أحرقتُ بيتك وأثاثه وقت اشتغالك في البيت فماذا كان سيحصل يا ترى؟!
باختصار، يجب على المتقي اجتناب السيئات. وتليها مرحلة إفاضة الخير، وقد عُبّر عنها هنا بلفظ (المحسنين)، أي أن مِن واجب المتقي بعد ذلك أن يفعل الخيرات أيضا. إذ لا يكون المرء صالحا كامل الصلاح إلا أن يجتنب السيئات أولًا ثم يرى ما هي الحسنات.
يُروى أن خادمًا أحضر للإمام الحسين رضي الله عنه فنجانا من الشاي، وعندما اقترب منه سقط الفنجان على رأس الإمام بخطأ من الخادم، فتأذى الإمام ونظر إليه شزرًا. فقرأ الخادم بصوت خافت: “وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ”، فقال الإمام: “قد كظمتُ ” فقال الخادم: “وَالْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ” -علمًا أن الكاظم يكبت غيظه ولا يبديه، لكنه لا يكون راضيًا عن المخطئ كلَّ الرضى، ولذلك وضع الله تعالى هنا شرط العفو- فقال الإمام: “قد عفوتُ عنك.” فقرأ الخادم: “وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ”، أي أنما المحبوبون عند الله يحسنون إلى الناس بعد الكظم والعفو. فقال الإمام: اذهبْ فأنت حرٌّ. هذه هي أسوة الصالحين، حيث نال هذا الخادم حريته من سيده نتيجة سقوط فنجان الشاي عليه. وتعلمون أن هذا النموذج الجميل لم يكن إلا نتيجة جمال التعليم.
قوة النبي صلى الله عليه وسلم القدسية
يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم “فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ” (هود:112)، أي كُنْ مستقيما بحيث لا يبقى فيك أدنى عوج من سوء الأعمال، وعندها سأكون راضيا عنك. والمراد أن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستقيما بنفسه، وأن يجعل الآخرين أيضا مستقيمين. كم كان صعبًا تقويم العرب!
(جريدة الحكم، بتاريخ 31-7-1901م)
لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى استفسار الناس: “شَيَّبَتْنِي هُودٌ”، لأن هذا الأمر الربَّاني قد حّملني مسؤولية جسيمة جدا. ذلك أنه يمكن للمرء أن يقوّم نفسه ويطيع أوامر الله تعالى طاعة كاملة، أما أن يجعل الآخرين مستقيمين ومطيعين، فهذا ليس بسهل أبدا. ومن هنا يتجلى سموُّ مكانة نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم وعظم قوته القدسية. انظروا كيف عمل صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الربَّاني حيث أعدَّ جماعة طاهرة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حتى وصفهم الله بقوله: “كُنْتُمْ خَيَْر أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ” (آل عمران:110)، وسمعوا نداء الله: “رَضِيَ اُلله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ” (البينة:8). ولم يبق إلى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم أي منافق في المدينة الطيبة.
باختصار، قد حقق النبي صلى الله عليه وسلم نجاحًا لم يوجد له مثيل في وقائع حياة أي نبي آخر. وقد أراد الله تعالى ببيان ذلك ألا يقتصر أمرنا على ثرثرة اللسان فقط، إذ لو بقي مقتصرا على القيل والقال والرياء فقط فما الذي يميّزنا عن غيرنا، وما وجهُ فضلنا على الآخرين؟ إنما عليكم تقديم نموذجكم العملي، ويجب أن يحمل من البريق ما يجعل الآخرين يقبلونه، إذ لن يقبله أحد بدون بريق فيه. هل يرضى المرء بشيء متّسخ؟ لا يُعجِبُ المرءَ ثوب فيه بقعةُ وسخ واحدة،كذلك لن يرغب فيكم أحد ما لم تكن في بواطنكم صفاء ولمعان. كل إنسان يحب الشيء النفيس، كذلك لن تبلغوا أي مقام من الروحانية بدون التحلي بالأخلاق السامية.
غاية خلق الإنسان
لقد ذكَر الله تعالى في سورة العصر نماذجَ حياة الكفار والمؤمنين. إن عيشة الكفار كعيشة الأنعام تماما التي لا هَمَّ لها سوى الأكل والشرب وإشباع الغرائز الشهوانية: “يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ” (محمد:12) ولكن لو أكل الثور العلف وطرح نفسه على الأرض عند الحراثة، فما سيكون مصيره؟ سيأخذه الفلاح إلى المجزرة ويبيعه للجزار.كذلك يقول الله تعالى عن الذين لا يتبعون أوامره ويعيشون في الفسق والفجور: “قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ” (الفرقان:77)، أي ماذا سيكترث الله لكم إن لم تعبدوه؟ ألا فاسمعوا بقلوب واعية أنه لا بد لعبادة الله تعالى من الحب.
والحب قسمان: أحدهما الحبُّ الذاتي، والآخر الحبُ الناشئ عن أطماع، أي يكون وراء الحب دوافع آنية، فيفتر فور زوال تلك الدوافع مسفرًا عن ألم وحزن. أما الحب الذاتي فيهب السعادة الحقة. ولأن الإنسان مجبول بفطرته على أن يكون لله تعالى، حيث قال الله تعالى: “وَمَا خَلَقْتُ الِْجنَّ وَالِأنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ” (الذاريات:56)، فقد أودع الله تعالى شيئًا لنفسه في فطرة الإنسان، وخلَقه لنفسه سبحانه وتعالى بأسباب خفية جدًّا. مما يوضح أن الله تعالى قد جعل غاية خلقكم الحقيقية أن تعبدوه، والذين يعرضون عن هذه الغاية الأساسية الفطرية ويجعلون غاية حياتهم الأكل والشرب والنوم كالأنعام فإنهم يبتعدون عن فضل الله تعالى، ولا يكون الله مسؤولا عنهم. إن الحياة التي هي حياة المسؤولية إنما أن يؤمن بقول الله تعالى: “وَمَا خَلَقْتُ الِْجنَّ وَالِْإنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ” (الذاريات:56) ويغيّر المرء منحى حياته، لأن الموت يفاجئه. وما أصدقَ ما قاله سعدي في بيت شعر له:
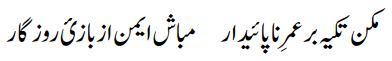
أي: لا تَثِقْ بالحياة الفانية، ولا تأمن صروف الدهر.
الاتكال على الحياة الفانية ليس من دأب العاقلين، لأن الموت يفاجئ الإنسان ويصرعه من حيث لا يحتسب. وحيث إن الإنسان واقع في قبضة الموت على هذا النحو فمن ذا الذي يمكن أن يضمن حياته سوى الله تعالى.
تكريس الحياة لله
أما لو صارت حياة المرء لله تعالى فإنه سوف يتولى حفظه وحمايته. هناك حديث في صحيح البخاري أن العبد إذا أحبّ ربه سبحانه وتعالى أصبح الله جوارحه. وفي رواية أن المرء يبلغ في ولاية الله مقاما يصبح الله فيه يدَه ورجلَه وما إلى ذلك حتى يصير لسانَه الذي يتكلم به. الواقع أن الإنسان إذا تنزّهَ عن أهواء النفس، وسار تحت إرادات الله تماما، متخليا عن نفسانيته، فلا يصدر منه ما هو غير جائز، بل تصبح أفعاله كلها موافقة للمشيئة الإلهية، وفوق ذلك يعُدّ الله تعالى أفعاله أفعالًا له سبحانه وتعالى.
هذا مقام من قرب الله تعالى قد تعثر عنده قوم لم يقطعوا منازل السلوك كاملة، أو أساء فهْمَه قوم يجهلون الإلهيات ولا يعرفون مفهوم قرب الله تعالى، فابتدعوا عقيدة وحدة الوجود. يجب ألا يغيبن عن البال أن الفعل الذي يقع فيه المرء في الابتلاء لا يكون موافقًا لإرادة الله تعالى، بل تكون مشيئة الله خلافه، وصاحب هذا الفعل يتّبع أهواءه لا مشيئة الله. أما الذي يكون ولّي الله والذي يكون الله مسؤولا عن حياته، إنما هو ذلك الذي لا يقوم بحركة ولا سكون إلا باسترشاد من كتاب الله تعالى، ويرجع في كل أمر وفي كل إرادة إلى كتاب الله ويسترشده.
ثم ورد في رواية أن الله تعالى يتردد كثيرا في قبض روح مثل هذا العبد. والحق أن الله تعالى أسمى من التردد، وإنما المراد من ذلك أنه يتوفاه ويأخذه إلى العالم الآخر من أجل مصلحة عظيمة، وإلا فإن الله تعالى يحب جدا أن يبقى عبده هذا في الدنيا طويلا. فلو أن الإنسان لم يعشْ عيشةً بحيث يتردد الله تعالى في قبض روحه فهو أسوأ من الحيوانات. إن الماعز الواحد يمكن أن يعيش عليه عدة أشخاص أياما، كما أن جلده أيضا نافع، ولكن لا خير في الإنسان الطالح حيًّا ولا ميّتًا. أما الرجل الصالح فيسري تأثيره في ذريته أيضا وينتفعون منه، والحق أنه لا يموت، بل يوهب بعد الموت حياة جديدة. لقد قال سيدنا داود عليه السلام: كنت طفلًا وقد شِخْتُ ، ولم أَرَ عابدًا صادقًا لله يرى الذلّ، ولم أر أولاده يتكففون الناس. وهذا يعني أن الله تعالى يتولى أولاد الإنسان المتقي. بينما ورد في الحديث أن الظالم يظلم أهله وعياله، لأن تأثيره السيئ يصل إليهم.
غاية خلق الإنسان هي العبادة
فكم هو ضروري أن تدركوا أن غاية خلْق الله لكم إنما هي أن تعبدوه وتكونوا له، ولا تكون الدنيا هدفكم المنشود. وأبيُّن هذا الأمر لكم مرارا وتكرارا، لأني أرى أن هذه هي غاية مجيء الإنسان إلى الدنيا، وهذا هو الأمر الذي هو بعيد عنه. إني لا أقول لكم أن تتخلوا عن أمور الدنيا كلية، وتتركوا أهليكم وأولادكم وتذهبوا بعيدا إلى غابة أو جبل وتقبعوا فيه. كلا، إن الإسلام لا يجيز ذلك، وليست الرهبانية هدفه.
إنما يريد الإسلام أن يكون الإنسان نشيطا ومجتهدا ومجدّا، لذا أقول: عليكم أن تنجزوا أمور دنياكم بجد واجتهاد. ورد في الحديث أن مَن كانت عنده أرض ولم يعمرها فهو مؤاخَذ عند الله تعالى. فمَن فَهِمَ مِن قولي هذا أني أدعوكم إلى التخلي عن أمور دنياكم فهو مخطئ. كلا، إنما أعني أن تبتغوا رضا الله تعالى في كل ما تقومون به من أعمال الدنيا، وألا تؤْثروا مآربكم وأهواءكم على إرادته ومشيئته تعالى.
(جريدة الحكم، بتاريخ 10-8-1901م)
أما إذا جعل المرء غاية حياته أن يعيش منغمسا في الملذات وجعل الأكل والشرب والثياب والنوم منتهى أَرَبه، ولم يبق لله مكان في قلبه، فاعلموا أنه يريد أن يقلبَ فطرة الله، وسيكون مآله أنه سيجعل قواه وكفاءاته عديمة الجدوى بالتدريج. من المعلوم أننا لو اشترينا شيئا لهدف ما، ولكنه إذا لم يحقق ذلك الهدف، فسوف يصبح عديم الجدوى. فمثلا لو اشترينا الخشب لنصنع به كرسيا أو طاولة، ثم ثبت أنه لا يصلح لذلك فسوف نستخدمه حطبًا، كذلك فإنما غاية خلق الإنسان الحقيقية عبادة الله، ولكنه لو قلب فطرته بتأثير الأسباب والعلاقات الخارجية وأفسدها، فلن يعبأ به الله تعالى. وهذا ما تشير إليه الآية: “قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ” (الفرقان:77).
لقد ذكرت من قبل أيضا أني رأيت في الرؤيا أني واقف في فلاة وهناك قناة طويلة شرقًا وغربً، ملقاة عليها الشياه، ولذبح كل شاةٍ هناك جزّار مكلّف بذلك، وفي يده سكّيٌن وقد وضعها على عنقها وقد جعل وجهه إلى السماء، وأراني أتمشى بالقرب منهم، وفهمتُ برؤية هذا المشهد أنهم ينتظرون أمرًا من السماء، وعندئذ تلوت هذه الآية نفسها: “قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُم” (الفرقان:77)، وما إنْ سمع الجزّارون الآية إلا ومرّروا سكاكينهم قائلين: إنْ أنتن إلا شياهٌ آكلةُ النجاسة.
باختصار، إن الله تعالى يعبأ بحياة المتقي وبقاؤه عزيز عليه، ولكن الذي يخالف مرضاة الله فإنه تعالى لا يعبأ به ويلقيه في جهنم. لذا يجب على الجميع أن يحرر نفسه من عبودية الشيطان. وكما أن الكلوروفورم يُنوّم الإنسان كذلك فإن الشيطان ينوّمه نومة الغفلة، ويهلكه خلالها.
ذكر فئتين في سورة العصر
أعود لمقصدي الأصلي ثانية وأقول: إن الله تعالى قد ذكر في سورة العصر فئتين، فئة الأبرار والأخيار، وفئة الكفّار والفجّار. وقال عن الكفّار الفجّار: “إِنَّ الِْإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ” (العصر:2)، وفصل عنهم الفئةَ الأولى فقال: “إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَِحاتِ” (العصر:3)، أي أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات ليسوا من الخاسرين. لقد تبين من هنا أن الخاسرين هم أولئك الذين ليسوا مؤمنين ولا يعملون الصالحات.
علمًا أن كلمة الصلاح تُستخدم فيما ليس فيه أدنى أثر للفساد، ولا يُعَدّ المرء صالحا ما لم يتخلص من المعتقدات الرديئة والفاسدة، وما لم تتنزه أعماله أيضا عن الفساد. ولفظ المتقي من باب الافتعال الذي يفيد التكلف، مما يعني أنه بحاجة إلى كثير من المجاهدة والسعي، ويكون في حالة النفس اللوامة أثناءَ مجاهداته. عندما يعيش المرء عيشة الأنعام يكون في حالة النفس الأمارة، فإذا تطور وتغلّب على النفس الأمارة صار في حالة النفس المطمئنة. والمتقي يتطور ويخرج من حالة النفس الأمارة ويصير في حالة النفس اللوّامة، ولذلك قيل في المتقين: “الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ” (الَأنْفال:3)، وكأنهم في حرب في صلاتهم حيث تهاجمهم الوساوس والأوهام وتحيّرهم، ولكنهم لا يضيقون ذرعًا ولا تسبب لهم هذه الوساوس فتورا ولا تعبًا، بل يستعينون بالله تعالى مرة بعد أخرى، ويصرخون ويبكون فيقهرون الوساوس والشبهات. كما أن الشيطان ينهاهم عن إنفاق أموالهم، ويُريهم الإسرافَ والإنفاقَ في سبيل الله سيّين، مع أنه شتّانَ بينهما، لأن المسرف يهدر أمواله بدون جدوى، أما المنفق في سبيل الله فإن ما ينفقه يُرَدّ إليه، فينفق أكثر من ذي قبل، ومن أجل ذلك قيل في المتقين: “وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ” (الأنفال:3).
الصراط المستقيم
الواقع أنه لا مناص للإنسان في حالة الصلاح من أن يكون منزهًا عن كل أنواع الفساد، سواء في العقائد أو الأعمال. وكما أن جسد الإنسان لا يكون في حالة الصلاحية إلا إذا كانت جميع أخلاطه في حد الاعتدال، دون نقص أو زيادة، إذ لو تجاوز شيء منها حد الاعتدال مرِضَ الجسدُ، كذلك فإن صلاح روح الإنسان أيضا متوقف على الاعتدال، وهو الصراط المستقيم في مصطلح القرآن الكريم. في حالة الصلاح يصبح الإنسان لله فقط، مثل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم يتطور الإنسان الصالح رويدا رويدا ويبلغ مقام النفس المطمئنة، وهنالك يتيسر له انشراح الصدر، كما قال الله تعالى لرسوله :صلى الله عليه وسلم “أَلَم نَشْرَح لَكَ صَدْرَكَ” (الشرح:1). غير أنه ليس بوسعنا بيان كيفية انشراح الصدر بالكلمات.
صدر الإنسان كبيت الله وقلبه كالحجر الأسود
تذكروا بقلوب واعية أنه كما أن الحجر الأسود موضوع في بيت الله كذلك القلب موضوع في الصدر. لقد جاء على بيت الله زمان وضعَ فيه الكفار الأصنام. وكان من الممكن ألا يأتي ذلك الزمان على بيت الله، ولكن الله تعالى سمح بذلك ليكون نظيًرا ومثالا للناس. إن قلب الإنسان أيضا يشبه الحجر الأسود، وصدره يشبه بيت الله، وإن أفكار ما سوى الله هي بمنزلة الأصنام الموضوعة في الكعبة، وقد كُسرتْ أصنام مكة حين ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عشرة آلاف قدوسي، وتم فتحُها. لقد سّمي هؤلاء العشرة آلاف صحابي ملائكةً في الكتب السابقة، والحق أن شأنهم كان كشأن الملائكة تماما. إن القوى البشرية أيضا بمنزلة الملائكة من وجهٍ، إذ ورد في صفتهم أنهم: “يَفْعَلُونَ مَا يؤُمَرُونَ” (النحل:50)، كذلك فمن خاصية القوى البشرية أنها تفعل ما تؤمر، وإن جميع القوى والجوارح البشرية تابعة لأوامر الإنسان. فلا بد لإلحاق الهزيمة بأصنامِ ما سوى الله تعالى وللقضاء عليها مِن شَنِّ هجومٍ مماثلٍ عليها. والجند الذي يشنّ هذا الجُوم إنما يُعَد بتزكية النفس، ولا يُكتَب النصر إلا لمن يقوم بتزكية نفسه، فقد قال الله تعالى: “قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا” (الشمس:9). وورد في الحديث الشريف أنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله. وما أصدقَه مِن قولٍ، فإن العين والأذن والرِّجل واللسان وغيرها من الأعضاء والجوارح كلها تعمل بأوامر القلب، حيث تخطر بالقلب فكرة عن أمر فلا يلبث العضو المتعلق به أن ينفذها.
اتبعوني وأطيعوا أمري
هناك ضرورة لنوع من الجهاد لتطهير بيت الله هذا من الأوثان. وها إني أدلكم على سبيل هذا الجهاد، وأؤكد لكم أنكم لو عملتم به لحطَّمتم هذه الأوثان. وهذا السبيل ليس من اختراع نفسي، بل قد أمرني الله تعالى بأن أخبركم به. وما هو ذلك السبيل؟ إنما هو أنْ تطيعوني وتتّبعوا خطواتي. وهذا النداء ليس بالجديد، بل قال رسول الله الذي طهر مكة من الأصنام: “قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ” (آل عمران:31) كذلك فلو اتبعتموني لتمكنتم من كسر الأوثان التي هي في باطنكم، وقدرتم على تطهير صدوركم المليئة بأنواع الأصنام.
لا حاجة بكم للاعتكافات الأربعينية من أجل تزكية النفوس؛ إذ لم يقم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذه الاعتكافات الأربعينية، ولم يقوموا بهذه الأوراد المختلفة من قبيل ما يسمى ذِكْر الأرّه والنفي والإثبات وما إلى ذلك. كلا، بل كانوا يملكون شيئا آخر تماما، ألا وهو أنهم كانوا متفانين في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النور الموجود في شخصه صلى الله عليه وسلم ينزل على قلوبهم عبر أنبوب الطاعة هذا، فكان يقضي على فكرة كل ما سوى الله قضاء نهائيا، ويملأ صدورهم نورًا مكان الظلام.
واعلموا جيدا أن الأمر نفسه الآن أيضا، فما لم ينزل على قلوبكم النور الآتي من أنبوب الله تعالى، فلن تتزكى نفوسكم. إن صدر الإنسان مهبطُ الأنوار، ولذلك يسمَّى بيتَ الله، وإن تحطيم ما فيه من الأصنام هو الأمر الأهم، لكي لا يبقى فيه إلا الله تعالى. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” الله الله في أصحابي” (سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أي ليس في قلوب أصحابي إلا الله فقط.
وليس المراد من كون الله وحده في القلب أن يؤمن المرء بعقيدة وحدة الوجود، ويعتبر أن كل كلب وحمار هو الله تعالى، والعياذ بالله. كلا، إنما المراد منه ألا يكون هدفُ المرء من كل عمل من أعماله إلا مرضاةَ الله. وهذه الدرجة لا تنال بدون فضل الله تعالى. ونِعْمَ ما قال الشاعر:
![]()
أي: لا شيء صعب على الكرام.
القرآن هدي لتكميل الإنسان علما وعملا
ثم اعلموا أيضا أن في القرآن الكريم الهَدْيَ لتكميل الإنسان علمًا وعَملًا، وأن قول الله تعالى: “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ” يشير إلى تكميله العلمي، وقوله تعالى: “صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ” بيان لتكميله العَملي، حيث بين الله تعالى أن هدي القرآن الكريم يعطي أكمل النتائج وأتّمها. فكما أن الشجرة التي تزرع لا تحمل الزهر والثمر ما لم يكتمل نماؤها، كذلك فإن الهدي الذي لا يأتي بأفضل النتائج وأكملها فهو هَدْيٌ ميّتٌ وعارٍ من أي قوة وقدرة على النماء.
فمثلًا ما الجدوى من هَدْي كتاب الفيدا الهندوسي ما دام من المستحيل على المرء العامل به حقَّ العمل أن يأمل في النجاة الأبدية ونيل السعادة الأبدية، متخلصًا من ولادته المتكررة على شاكلة الديدان والحشرات وغيرها؟ أما القرآن الكريم فإذا عمل بهديه الإنسان نال أسمى الكمالات، ونشأت له صلة حقة بالله تعالى، حتى إن أعماله الصالحة الصادرة بحسب هديِ القرآن تنمو كالشجرة الطيبة التي ضرب القرآن الكريم مثلها والتي تؤتي أُكُلَها العظيمة الحلاوة واللذة. فمن كان إيمانه مفتقرا إلى قوة النماء والازدهار فإيمانه ميت، فكيف يرجى أن تحمل شجرة إيمانه ثمارًا كالتي تحملها الشجرة الطيبة للأعمال الصالحة، ومن أجل ذلك قد وصف الله الصراط المستقيم بقوله: “صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ”، ليبين أن هذا الصراط لا يجعل سالكه حيرانَ وقلقًا وفاقِدَ الثمار، كلا بل إنه ينال بغيته وفلاحه.
سلب إيمان معارضي المأمور الرباني
ولا بد للإنسان من العبادة من أجل تكميله العَمَلي، وإلا فلن يعدو إيمانه مجردَ لعبة. ذلك أن الشجرة التي لا تحمل الثمار تكون عقيمة الجدوى مهما طالت وضخمت. وهذه هي حال معارضينا، مما يجعلهم عرضةً لخطر سلب الإيمان وحبطه، إذ يرون البارَّ شريرًا والمأمورَ الربَّاني كذّابًا، الأمر الذي يجعل المرء في حرب على الله تعالى. من البديهي أن الله تعالى قد أرسلني إلى الدنيا باسم المأمور والمسيح الموعود، فالذين يعارضونني، فإنهم لا يعارضونني، إنما يعارضون الله تعالى. فمعظمهم كانوا قبل دعواي يحترمونني ويجلّونني، وكانوا يعتبرون صبَّ الماء عليّ بالإبريق وقت وضوئي مدعاة للثواب ومفخرة لهم، وكان أكثرهم يحثُّون الناس على الدخول في بيعتي، ولكن لما بدأ أمري هذا باسم الله وإعلامه انبروا لمعارضتي، مما يدل على أنهم لا يعادونني عداءً شخصيا، إنما يعادون الله تعالى. لو كانوا على صلة حقيقية مع الله تعالى، فكان من مقتضى صلاحهم واتقائهم وخشيتهم أن يلبّوا ندائي قبل الآخرين، ويصافحوني، ويسجدوا سجود شكر لله تعالى. ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل خرجوا ضدي حاملين السلاح، وبلغوا في عداوتي أن سّموني كافرا وملحدا ودجّالا. لم يَدْرِ هؤلاء الحمقى للأسف أنه كيف يمكن أن يعبأ بسبابهم وشتائمهم شخصٌ يسمع نداء الله يقول له: “قل إني أُمرتُ وأنا أول المؤمنين. وأنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي”؟
من المؤسف حقًا أن هؤلاء الجهّال لا يدرون أنّ قضية الكفر والإيمان لا علاقة لها بأهل الدنيا، إنما هي بيد الله تعالى، والله تعالى يشهد على أني مؤمن ومأمور منه، فأَنَّى لي أن أعبأ بسبابهم؟
باختصار، إن هذه الأمور تدل على أنهم لم يعارضوني بل عارضوا أمر الله تعالى، وهذا هو الأمر الذي يسلب إيمان معارضي المأمور الربَّاني. ومن البديهي أن الذين يعارضونني إنما يعارضون الله تعالى. فإذا كنت أتقدم إلى النور- ومن المؤكد أنني أتقدم إلى النور باستمرار، إذ كانت ولا تزال تظهر من عند الله آيات كثيرة لتأييدي، وتنزل هذه الآيات من السماء نزول المطر- فمن المؤكد أيضا أن الذين يعارضونني إنما يتوجهون إلى الظلام. إن النور والضياء يأتي بروح القدس، وأما الظلام فيقرّب إلى الشيطان، وهكذا فإن معارضة الولي تسلب الإيمان وتجعل صاحبها قرينًا لمن وُصف ب (بئس القرين).
باختصار، لا يتأتى الإصلاح إلا بتحقق مراتب التكميل العَملي. وتشير كلمة “آمَنوا” في قول الله تعالى في سورة العصر: “إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَِحاتِ” (العصر:3)، إلى التكميل العِلمي، بينما تشير كلمة “وَعَمِلُوا الصَّالَِحاتِ” إلى التكميل العَملي. والحكمة أيضا جزءان: أحدهما أن يتيسر العلم الأكمل الأتّم، والثاني: أن يكون العمل على الوجه الأكمل والأتّم.
وتواصوا بالحق
لقد أخبرنا الله تعالى هنا أن المحفوظين من الخسران يقومون بتكميلهم العِلمي أولًا، ثم لا يقعون في السيئات، بل يبلّغون تكميلَهم العِلمي إلى درجة الكمال العَملي، ثم عندما تتيسر لهم البصيرة الكاملة ويتجلى كمال عِلمهم بكمال عَملهم، فلا يبخلون بل يعملون بقول الله تعالى “وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ”، ويدْعون الآخرين إلى الحق الذي وجدوه. ومن معاني “وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ” (العصر:3) أيضا أنهم يكشفون للآخرين نور أعمالهم أيضا، ذلك أن الواعظ إذا لم يعمل بما يعظ به فلا يكون لكلامه تأثير أبدا، بل الحق أنه إذا قال ما لا يفعله فإنه يترك في الآخرين تأثيرا سيئا جدا. فمثلا إذا منع الزاني من الزنا، ثم انكشفت حقيقةُ أمره للناس فيُخشى أن يصبح الذين يسمعون كلامه من الملحدين؛ إذ يقولون إذا كان الزنا أمرًا شنيعًا في الواقع، وإذا كان الزاني يعاقَب عند الله على تصرفه الخبيث هذا، وإذا هناك إلهٌ حقًا، فلماذا وقع هذا في هذه الفاحشة وهو ينهى عنها الآخرين؟
أعلَمُ شخصًا أراد أن يدخل في الإسلام نتيجة صحبة أحد المشايخ، ولكنه رآه ذات يوم يشرب الخمر، فقسا قلبه وامتنع عن قبول الإسلام.
باختصار، إن قوله تعالى: “تَوَاصَوْا بِالحَقِّ” يعني أنهم ينصحون الآخرين من خلال نور أعمالهم.
وتواصوا بالصبر
كما أن مِن شِيمتهم: “وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِْر”، أي أنهم ينصحون الآخرين بالصبر والمثابرة، فلا يُرغون ولا يُزبدون مستعجلين. إذا كان المرء شيخًا وإمامًا ثم يثور غضبا بسرعة ويفقد الصبر والأناة، فلماذا يضرّ الناس هكذا؟
والمعنى الثاني لقوله: “وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِْر” (العصر:3) هو أن الذي لا يسمع بصبر وهدوء فلا يستفيد من الوعظ. إن معارضينا لا يأتوننا بقلب حليم، ولا يذكرون مشاكلهم بصبر وهدوء، بل لا يريدون أن ينظروا في كتاب من كتبنا، ويسعون ليلبسوا الحق بالباطل مثيرين الضجة، فأنّى لهم أن يستفيدوا؟ ما الذي كان بأبي جهل وأبي لهب؟ لم يكن بهما إلا مرض الاستعجال وقلة الصبر؟ فقالا: إذا كنتَ قد جئتَ من عند الله ففجِّرْ لنا من الأرض ينبوعا. لم يصبر هذان الشقيّان وكانا من الهالكين، وإلا فقد أتت القناة التي فجّرتها “زبيدة” على أية حال،كذلك يقول معارضونا أنِ ادعُ لنا ويجب أن يجاب دعاؤك فورا، ويجعلون هذا الأمر معيارًا لمعرفة الحق من الباطل، ويقترحون من عندهم أمورا أخرى ويقولون: لو حَدَثَ كذا ووقع كذا لآمنّا، ولكن لا يقبلون أيّ شرط منا. من المؤسف حقًّا أن هؤلاء هم مصداق قوله تعالى: “وَلَا يََخافُ عُقْبَاهَا” (الشمس:15).
اعلموا أن الصابر وحده ينال مرتبة انشراح الصدر، أما الذي لا يصبر فكأنه يريد فرْضَ حُكمه على الله تعالى، ولا يريد أن يقبل حكومة الله على نفسه، ومثل هذا المتجاسر الوقح الذي لا يخاف جلال الله وعظمته يُحرم ثم يُقطَع.
صحبة الصادقين
ثم لا يغيبّن عن البال أيضا أن من شروط الصبر العملَ بقول الله تعالى: “كُونُوا مَعَ الصَّادِقِيَن” (التوبة:)118 إن المكوث في صحبة الصالحين ضروري. هناك كثيرون يعيشون بعيدين متقاعسين ويقولون: نعمْ، سوف نأتي لزيارتك في يوم من الأيام، ولسنا متفرغين في الوقت الحالي. إن الذي يجد جماعةَ الموعود المنتظر من1300 عام، ثم لا ينصرها ولا يحضر مجلس هذا الموعود من عند الله ورسوله، فأنى له أن ينال الفلاح؟ كلا، لن يناله. ولِله دَرُّ القائل:
![]()
أي: تريد وصال الله والدنيا الدنيةَ أيضا! هذا خيال ومحال وجنون.
إنما يريد الدِّينُ المكوثَ في الصحبة، فمن لم يرد الصحبة فكيف يَتوقع التدين والصلاح؟ لقد نصحت أحبائي مرارا وها إني أنصحهم مرة أخرى وأقول: عليهم أن يأتوا هنا مرة بعد أخرى، ويمكثوا وينتفعوا، ولكني أرى أن الاهتمام بهذا الأمر قليل جدا. يعاهدني الناس على إيثار الدين على الدنيا واضعين أيديهم في يدي، ثم لا يبالون بعهدهم هذا شيئا. اعلموا أن القبور تناديكم، والموت يقترب منكم كل حين، وكلَّ نفَسٍ تتنفسونه يقرّبكم من الموت، ولكنكم تظنونها ساعات الفراغ والبطالة. لا يليق بالمؤمن التحايل على الله تعالى. إذا جاء الموت فلن يتقدم ساعة ولن يتأخر. إن المعارضين الذين لا يقدرون هذه الجماعة ولا علم لهم بعظمتها دعوهم جانبا، ولكن الأشقى والأظلم مَن يعرف صدق هذه الجماعة وينضم إليها، ثم لا يقدرها حق قدرها. إن الذين لا يأتون هنا بكثرة، ولا يمكثون في صحبتي، ولا يسمعون ولا يرون ما يُظهره الله تعالى كل يوم من الآيات لتأييد جماعته هذه، فإنهم مهما كانوا صالحين وأتقياء وورعين إلا أني أقول إنهم ما قدروا هذه الجماعة حق قدرها. لقد قلت آنفًا إن الإنسان بحاجة لتكميله العَملي بعد التكميل العِلمي، والتكميل العَملي محال بدون التكميل العِلمي، وتكميلهم العِلمي صعبٌ ما لم يأتوا ويمكثوا هنا. تصلني رسائل كثيرة بأن فلانا أثار كذا وكذا من الاعتراض، ولكنا لم نستطع الردّ عليه. ما سبب ذلك؟ إنما سببه أن هؤلاء لا يحضرون هنا ولا يسمعون الأمور العِلمية التي يُريها الله تعالى لتأييد جماعته. إن كنتم قد عرفتم صدق هذه الجماعة حق المعرفة، وآمنتم بالله تعالى وعاهدتم بصدقٍ على إيثار الدين على الدنيا، فأسألكم: ما الذي عملتم بهذا الصدد؟ هل تظنون أن حُكم الله “كُونُوا مَعَ الصَّادِقِيَن” (التوبة:118) قد نُسخ؟ إن كنتم مؤمنين حقًا، وترون أن هذه هي السعادة الحقيقية، فآثِروا اَلله على كل شيء. أما إذا استهنتم بهذه الأمور واعتبرتموها عبثًا، فاعلموا أنكم ستُعَدّون من المستهزئين بالله تعالى.
(جريدة الحكم، بتاريخ 24-8-1901م)
الفاتحة تشمل جميع معارف القرآن
تَدبّروا سورةَ الفاتحة التي هي رسمٌ دقيق للقرآن الكريم، والتي تسمّى أم الكتاب أيضا لتضمُّنِها معارف القرآن كله إجمالًا. لقد بدأت هذه السورة بقوله تعالى: “الَْحمْدُ لله”، ومعناه أن المحامد كلها لله وحده. وقد عُلِّمنا بذلك أن كافة أنواع المنافع والخير والرخاء في الحياة المدنيّة إنما تأتي من عند الله تعالى، لأنه تعالى ما دام هو صاحبَ الحمد والثناء بكل أنواعه، فليس هناك مُعطٍ حقيقي إلا هو، وإلا للزم القول أنه لا يستحق بعض أنواع الحمد أو الثناء، وهذه الكلمة كفرٌ. فكم يحتوي قوله تعالى: “الَْحمْدُ لله” مِن تعليم رائع وجامع لتوحيد البارئ تعالى، حيث ينبّه الإنسان أن كل ما في الكون هو عبد لله تعالى، وليس بنافع في حد ذاته.كما يرسخ هذا التعليم في الأذهان بكل جلاء ووضوح أن كل نفع وخير إنما هو من عند الله تعالى في الواقع، لأنه تعالى هو صاحب المحامد كلها، فآثِروا الله دومًا على كل نفع وخير إذ ليس هناك من ناصر ولا معين سواه. إذا كان المرء يخالف رضا الله تعالى، فقد ينقلب أولاده أعداءً له، بل بالفعل يصبحون أعداءً في بعض الأحيان.
صفات الله تعالى
ثم إن سورة الفاتحة نفسها ترسم لنا ذلك الإله الذي يقدمه القرآن الكريم للناس ويطالبهم بالإيمان به. فقد ذكرت الفاتحةُ بالترتيب أربع صفات لله تسمى أمهات الصفات. وكما أن الفاتحة هي أم الكتاب كذلك فإن صفات الله المذكورة فيها هي أمهات الصفات، وهي: (رَبِّ الْعَالَمِين، الرَّحْمَٰنِ، الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)، وبالتدبر في هذه الصفات الأربع يتراءى للإنسان وجه الله تعالى.
والربوبية فيضها فيض واسع جدا وعام، وفيها إشارة إلى تكفُّلِ الله تعالى بتربية المخلوقات كلها في جميع مراحلها وتكميلِها. فكِّروا كم يصبح أمل الإنسان واسعًا حين يفكر في ربوبية الله تعالى.
أما الرحمانية فتعني أن الله تعالى يهيئ كافة الأسباب الضرورية لبقاء الموجودات بدون أي عمل من عامل. انظروا مثلًا إلى القمر والشمس والهواء والماء وما إلى ذلك، فكيف سخّرها الله تعالى لبقاء وجودنا بدون دعاء أو التماس أو عمل منا.
أما الرحيمية فتعني أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل.
أما صفة “مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ” فمن مقتضاها أن يجعلنا من الناجحين. فلو اجتهد الطالب من أجل الامتحان كثيرا ومع ذلك نقصت بضع علامات من أجل النجاح، فإن النظام الدنيوي سيُعلن فشله غيَر آبهٍ باجتهاده الشديد، ولكنّ رحيمية الله تعالى ستستره وتعلن نجاحه. فالرحيمية فيها نوع من الستر أيضا.
إن إله المسيحيين ليس ستّارًا على الإطلاق، وإلا فما الحاجة إلى الفداء والكفّارة؟ كذلك فإن إله الآريين الهندوس ليس ربًّا ولا رحمانا، إذ لا يقدر على أن يهب شيئًا بدون عمل ومقابل. وليس هذا فحسب، بل إنّ اقتراف الذنب ضروري بحسب مبدأ الفيدا على ما يبدو. فمثلًا لو أُريدَ إعطاءُ المرءِ حليبَ بقرةٍ جزاءً على عمله لاستلزم ذلك- بحسب روايتهم إن كانت صحيحة- أن تزني امرأةٌ من فرقة البراهمة، فتتحول إلى بقرةً عبَر عملية التناسخ جراء فاحشتها وفسقها، لتسقي هذا الإنسان حليبًا وإنْ كان زوجَها. باختصار، يستحيل لعامل أن ينال جزاء عمله من كنوز إله الفيدا ما لم تُرتكب هذه السلسلة من الأفعال، لأن نظام إله الفيدا كله قائم على هذا النمط.
أما الإسلام فقد قدّم ذلك الإله الذي يستحقّ المحامد كلها، ومن أجل ذلك فهو المعطي الحقيقي. وهو الرحمن يُنعِم بدون عملِ عامل. ثم إن “مالك يوم الدين” يجعل الإنسان ناجحا كما قلت آنفا. الحكومات الدنيوية لا تضمن أبدًا إعطاءَ وظيفة لكلّ حائز على شهادة البكالوريوس مثلا، ولكن حكومة الله كاملة وتملك الكنوز التي لا نفاد لها، ولا عوز عند الله تعالى، فيكتب النجاح لكل عامل، كما يستر بعض ما فيه من نقاط ضعف ونقائص إزاء حسناته وخيراته. وإنه تعالى توّاب وحَيِيٌّ أيضا، فهو يعلم الآلاف من عيوب عباده ولكنه لا يكشفها. غير أنه يأتي وقت حين يصبح المرء جريئا ويتمادى في سيئاته باستمرار، ولا يستفيد من حياء الله وستره، بل يتقوى فيه عِرق الإلحاد، وعندها لا تطيق غيرة الله أن يترك هذا المتجاسر الوقح بدون عقاب، فيلقى الخزي والهوان. كان حضرة المولوي عبد الله الغزنوي تلقى بشأن محمد حسين وحيًا يشير إلى عيب فيه، فطلب منه محمد حسين أن يخبره بذلك، فقال: إن حياء الله يمنعني من ذلك. كما أن حضرة الغزنوي كان رأى في الرؤيا أن ثياب محمد حسين قد تمزقت، وقد تحققت هذه الرؤيا الآن.
إنما قصدي من هذا البيان أن من خواص الرحيمية الستر أيضا، ولكن الاستفادة من هذا الستر يقتضي أن يكون هناك عمل من قِبل الإنسان، فلو بقي في عمله نقص أو عيب ستره الله تعالى برحيميته.
والفرق بين الرحمانية والرحيمية أنْ لا دخل للعمل أو الفعل في الرحمانية، أما الرحيمية ففيها دخل للعمل، ولكن يبقى في العمل نوع من الضعف أيضا، ورحمُ الله يقتضي ستْره. أما مَالِك يَوْمِ الدِّينِ فهو الذي يحقِّق الهدف الحقيقي. واعلموا جيدًا أن هذه الصفات التي هي أمهات الصفات صورةٌ تُرينا وجه الله تعالى روحانيا، إذ يتراءى لنا وجه الله على الفور بالتدبر فيها، وتقفز الروح بنشوة وتخرّ أمامه ساجدة. إذ بدأ هذا الذكر ب ” الْحَمْدُ لِلَّهِ” وهي صيغة الغائب، ولكن بعد ذكر هذه الصفات الأربع قد تغير هذا الذكر فجأة، لأن هذه الصفات قد قدّمت الله أمامنا عيانا، فكان حريا به وكان من مقتضى الفصاحة أيضا ألا يظل سبحانه وتعالى غائبًا، بل يتحول إلى مخاطَب حاضر، ومن أجل ذلك قد تحوّل الكلام هنا إلى الخطاب فقيل: “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ”.
واعلموا أنه ليس ثمة فاصلٌ بين “إِيَّاكَ نَعْبُدُ” و”إِيَّاكَ نَسْتَعِيُن”، غير أن “إِيَّاكَ نَعْبُد”ُ متقدم زمانًا إلى حد ما، لأن الله تعالى حين خلقَنا برحمانيته أناسًا ومنحَنا صنوف القوى والنعم، لم يكن هناك أي دعاءٍ أو طلبٍ مِن قِبلنا، وإنما فعَل ذلك كله بمحض فضله، وهذا هو التقدم.
الرحمانية والرحيمية
وأعود ثانية إلى ما كنت بصدد بيانه وأقول اعلموا أن الرحمة نوعان، أوّلهما يسمَّى الرحمانية والآخر الرحيمية. والرحمانية فيضٌ بدأَ قبْل وجودنا وخلْقِنا. فمثلًا قد خلق الله قبل وجودنا أيضا الأرضَ والسماء والقمر والشمس وغيرها من الأشياء الأرضية والسماوية، وهي كلها نافعة لنا وتنفعنا فعلًا. لا شك أن الحيوانات الأخرى أيضا تستفيد من هذه الأشياء، ولكن الحيوانات نفسها ما دامت تنفع الإنسان وتخدمه، فثبت أن المستفيد الحقيقي من كل هذه الأشياء هو الإنسان في الحقيقة. ترون في الأمور الجسمانية كيف أن الإنسان يأكل أطيب الأطعمة وأفضلها، وكيف أن أجود اللحم يكون من نصيب الإنسان، أما العظام والأجزاء الرديئة فتكون للكلاب. لا شك أن الدواب تستمتع باللذة الجسمانية لحد ما، ولكنها لا تكون شريكة للإنسان في اللذة الروحانية.
باختصار، هذان نوعان من الرحمة، وقد أُعطينا أَوَّلَهما حتى قبل وجودنا، وأما الثاني، أي الرحيمية، فتتجلّى مظاهره بعد الدعاء ويقتضي منا العمل والجهد.
العلاقة بين الدعاء ونواميس الطبيعة
وأرى من المناسب هنا أن أبين أن الدعاء وثيق الصلة بالنواميس الطبيعية دائما. إن الطبيعيين المعاصرين الذين يجهلون العلوم الحقة كلَّ الجهل والذين جُلُّ هّمهم تقليدُ الأوروبيين في طريقة عيشهم، يعتبرون الدعاء بدعة، لذا أرى لزاما عليّ أن أبين هنا موضوع الدعاء بإيجاز.
ترون أن الرضيع عندما يضطرب من شدة الجوع ويبكي ويصرخ للحليب، يتدفق الحليب في ثدي أمه. ومع أن الرضيع لا يعرف حتى اسم الدعاء، إلا أن صرخاته تجلب الحليب، فما السبب وراء ذلك؟ هذا أمر قد جرّبه الجميع عموما. ومن الملاحظ أن الأم لا تشعر بوجود الحليب في ثديها أحيانا، بل لا يوجد بالفعل في بعض الأحيان، ولكن ما إنْ تصل صرخاته الأليمة إلى مسامعها حتى يتدفق الحليب في ثدييها. وكما أن هناك صلة وثيقة بين صرخات الرضيع وبين تدفق الحليب، فأقول والحق أقول لو كانت صرخاتنا أمام الله مليئة بالاضطرار والألم اللذين يوجدان في صرخات الوليد، فلا بد أن تستثير فضل الله ورحمته وتجذبها جذبًا. وأقول بناءً على خبرتي فإني قد أحسست بل رأيتُ فضل الله ورحمته -اللذين ينزلان نتيجة استجابة الدعاء- ينجذبان إلّي انجذابًا، أما إذا لم يحس الفلاسفة المعاصرون ذوو العقول المظلمة بهذه الحقيقة أو لم يروها، فهذا لا يعني أن هذه الحقيقة منعدمة من الدنيا، ولاسيما ونحن مستعدون في كل وقت لإراءة نموذج استجابة الدعاء.
باختصار، إن نظائر استجابة الدعاء لموجودة في نواميس الطبيعة، ويرسل الله في كل زمان نماذج حية لذلك، ومن أجل ذلك علّمنا الله تعالى دعاء “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ”. إن هذه مشيئة الله وقانونه، وليس بوسع أحد أن يبدلها.
إن قوله تعالى “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ” دعاءٌ بأن يجعل الله أعمالنا كاملة أتَّم الكمال. والتدبر يكشف أن هذه الكلمات، وإن كانت تأمرنا بالدعاء للاهتداء إلى الصراط المستقيم، إلا أن كلمات “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ” التي سبقتها تشير إلى أن واجبنا اغتنام هذه الفرصة المتاحة لنا، أعني أن نستعين بالله تعالى مستخدمين قوانا السليمة على السير في الصراط المستقيم. لذا فلا بد من الأخذ بالأسباب الظاهرية أيضا، ومَن تركها فقد كفر بنعمة الله. فمثلًا إن اللسان الذي خلقه الله من العروق والأعصاب، إذا لم يكن كما هو لما قدرنا على الكلام. لقد رزقنا الله للدعاء لسانًا قادرا على التعبير عما تختلج في قلوبنا من نوايا وأفكار، وإذا لم نستخدم اللسان للدعاء فهي شقاوتنا. هناك أمراض عديدة لو أصابت اللسان لتعطّلَ عن العمل. فهذا المثال يبين لنا رحيمية الله تعالى. كذلك قد أودع الله قلوبَنا الخشوعَ والخضوعَ وقوةَ التفكر والتدبر، ولو دعَونا الله تعالى بدون بذل هذه القوى والقدرات فلن يكون دعاءً مجديا ونافعا أبدا، إذ لم نستفد من العطية الأولى فماذا عسى أن نستفيد من الثانية؟ فكأن ورود “إِيَّاكَ نَعْبُدُ” قبل “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ” يعني أننا نقول لربنا: ربنا إننا ما أضعْنا المواهب والقوى التي أعطيتَنا من قبل أيضا. واعلموا أن ميزة الرحمانية أنها تجعل الإنسان أهلًا للاستفادة من الرحيمية، ولذلك قال الله تعالى: “ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ” (غافر:60). هذا ليس كلاما فارغا، بل هذا ما يقتضيه الشرف الإنساني. إن الدعاء من صفات الإنسان، ومن لم يسأل الله تعالى استجابة دعائه فهو ظالم. إن الدعاء حالة من السرور والمتعة اللذينِ لا أجد كلمات لبيانهما للدنيا للأسف، لأن هذه المتعة لا تُدرَك إلا بالخبرة.
قصارى القول، إن من أول شروط الدعاء أن يعمل المرء الصالحات، ويعتقد اعتقادا سليما، لأن الذي يدعو الله تعالى بدون إصلاح المعتقدات وفعْل الصالحات فكأنما يختبر الله تعالى. الحق أننا بقولنا: “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ” نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالَنا أكملَ وأتَّم، ثم نصرح أكثر ونقول: “صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ”، أي أننا نريد أن تهدينا إلى صراط المنعم عليهم، وتنقذنا من صراط المغضوب عليهم الذين حلَّ بهم العذاب نتيجة سوء أعمالهم وأما قوله تعالى “وَلَا الضَّالِّيَن” فعلّمَنا فيه أن ندعوه بأن يحفظنا من أن نكون من المحرومين من حمايته، فنظل هائمين على وجوهنا بعيدا عن الصراط المستقيم.
وجدير بالذكر هنا أن هذه الآيات جاءت على طريقِ اللَّفِّ والنشرِ المرتَّب، إذ قيل هنا أولًا: “الْحَمْدُ لِلَّهِ”، أي أن الله تعالى مستجمعٌ للصفات الكاملة، ومتصفٌ بالمحاسن كلها، ومنزه عن العيوب والنقائص جمعاء، وثانيا: “رَبِّ الْعَالَمِيَن” وثالثا: “الرَّحْمَٰنِ” ورابعا:”الرَّحِيمِ” وخامسا: “مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ”، والطلبات الخمسة المذكورة بعد ذلك جاءت كلها منسجمة مع هذه الصفات الخمس تماما، حيث قيل: “إِيَّاكَ نَعْبُدُ” إزاءَ “الْحَمْدُ لِلَّهِ”، أي يا إلهَنا المستجمع للصفات الحميدة كلها والمنزه عن العيوب كلها، إنما نعبدك أنت وحدك. إن المسلم يعرف ذلك الإله الذي هو متصف بجميع تلك المحاسن التي يتصورها العقل الإنساني، بل إنه تعالى أسمى وأرفع من ذلك أيضا، إذ الواقع أن عقل الإنسان وفكره لا يقدران على الإحاطة بصفات الله أبدا. فالمسلم يؤمن بهذا الإله المتصف بالصفات الكاملة، أما سائر الأمم فتتعرض عند ذكر إلهها في المجالس للخجل والندم، ويجب أن تخجل.
تَصَور الإله عند الهندوس
خذوا الهندوس مثلًا، فإن الإله الذي يؤمنون به ويقولون إن كتابهم “الفيدا” يقدّم ذلك الإله، لو ذكروا في مجلس أن إلههم هذا لم يخلق ولا ذرة من الكون ولم يخلق الأرواح أيضا، فهل يبقى لقائل هذا الكلام مجال للفرار إذا قيل له: ما الحرج إذا مات مثل هذا الإله؟ ذلك أن الأشياء ما دامت قد وُجدت بنفسها، وما دامت قائمة بذاتها كما يزعمون، فما الحاجة لحياة هذا الإله من أجل حياتها وبقائها؟ فمثلًا لو أطلق المرء سهمًا ثم ماتَ والسهمُ منطلق إلى هدفه، فأيُّ تغير يمكن أن يطرأ على السهم، لأنه بعد انطلاقه ليس بحاجة إلى مَن أطلقه. كذلك فلو جازَ الموت لإله الهندوس في وقت من الأوقات فليس بوسع هندوسي أن يبين لنا الخسارة التي يؤدي إليها موته. ولكن لا يمكننا قول ذلك بحق الله تعالى، لأن لفظ “الله” نفسه يدل على أنه بريء من كل عيب ونقيصة.
وبالمثل يؤمن الآريون بكون الأجسام والأرواح أزلية، أي أنها موجودة منذ الأزل. لو قلنا لهم: أي دليل يمكن أن تقدموه على وجود الإله مع إيمانكم هذا؟ فلو قالوا: إن الإله قام بتركيب الأرواح والذرات بعضها ببعض، لقلنا: ما دمتم تؤمنون بأن الذرات والأرواح أزلية وقائمة بذاتها، فتركيب بعضها ببعض ليس إلا عملا أدنى، ويمكن أن تتركب بنفسها.
كذلك حين يقول لنا الآريون أن من تعاليمهم أن إلههم يأمرهم في كتابهم “الفيدا” بأن المرأة إذا لم تقدر على الإنجاب من زوجها، فعليها أن تضاجع رجلا أجنبيا لتنجب الأولاد، فماذا عسى أن يقال عن مثل هذا الإله؟ أو لو قالوا أن من تعاليمهم بأن الإله لا يعطي النجاة الأبدية أيًا من محبيه الصالحين، بل لا بد له عند القيامة الكبرى من إلقاء الناجين في دورة التناسخ مرة أخرى، أو لو قالوا أن إلههم لا يعطي أحدًا أي شيء فضلا منه وكرمًا، بل ينال كل إنسان نتائج أعماله فقط، فما الحاجة إلى مثل هذا الإله أصلا؟ باختصار إن الذي يؤمن بمثل هذا الإله يتعرض لندم شديد.
تَصَور الإله عند المسيحيين
كذلك عندما يقول المسيحيون بأن إلههم هو يسوع، ثم يقولون أنه ضُرب على أيدي اليهود، وظل يُختبر على يد الشيطان، ويقاسي آلام الجوع والعطش، وفي النهاية عُلّق على الصليب فاشلا، فهل من عاقل سيرضى بمثل هذا الإله؟
باختصار، إن كل الأمم تتعرض للندم والخجل على هذا النحو عند ذكرهم آلهتهم، ولكن المسلم لا يلقى الندم عند ذكره إلهه في أيّ مجلس أبدًا، إذ ليست هناك ميزة أو صفة حسنة إلا وتوجد في الإله الذي يؤمن به المسلم، وما من عيب ونقيصة إلا هو منزه عنها، كما نجده تعالى قد وُصف في سورة الفاتحة بالصفات الحميدة كلها.
باختصار قد ورد: “الْحَمْدُ لِلَّهِ”، إزاء “إِيَّاكَ نَعْبُدُ”.
ثم قال الله تعالى: “رَبِّ الْعَالَمِيَن” ومهمة الربّ التربيةُ والتكميل، كما تربي الأم ولدها وتنظّفه وتزيل عنه كل نوع من النجاسات والشوائب، وترضعه، وبتعبير آخر تساعده. وقد ورد إزاء صفة “رَبِّ الْعَالَمِيَن” قولُ الله تعالى “وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن”.
ثم وردت صفة “الرَّحْمَٰنِ” مَن يعطي بفضله دون طلبٍ أو عملٍ. وعلى سبيل المثال، لو لم نُخلَق بهذه البنْية التي خُلقنا بها لما استطعنا السجود ولا الركوع، ولذلك قيل مقابل الربوبية: “وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن” وكما أن الحديقة لا تنمو بغير الماء، كذلك لو لم يصلنا ماءُ فيض الله ولطفِه لما استطعنا النماء والترقي. تمتصّ الشجرة الماء لأن في جذورها مَسام وثقوبًا، ومعلوم في العلوم الطبيعية أن فروع الشجرة تجتذب الماء لأن فيها قوة الجذب، وكذلك تكون في العبودية أيضا قوةُ الجذب التي تجتذب فيضَ الله وتمتصّه. باختصار، قد ذكُرتْ صفة ” الرَّحْمَٰنِ” مقابل “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ”، ومعناه أنه لو لم تحالفنا رحمانيتك، ولو لم تعطنا هذه القوى والقدرات، فأَنّى لنا أن نستفيد من فيضك هذا.
(جريدة الحكم، بتاريخ 10-9-1901م)
بالرحمانية يتيسر الهدى
فقد وردت “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ” مقابل صفة “الرَّحْمَٰنِ” ، لأن نيل الهداية ليس حقًا لأحد، وإنما يُنال هذا الفيض بمحض رحمانية الله.
ثم جاء قول الله تعالى “صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ” مقابل صفة “الرَّحِيمِ”، لأن الذي يقوم بهذا الدعاء ينال الفيض من نبع الرحيمية، وكأنه يقول: يا مجيبَ الدعوات برحمتك الخاصة، أَرِنا صراط الرسل والصديقين والشهداء والصالحين الذين حازوا منك إنعامَ أنواع المعارف والحقائق وصنوف الكشوف والإلهامات نتيجة عكوفهم على الدعاء والمجاهدات، وتوصلوا إلى المعرفة التامة بمواصلة الدعاء والتضرع والأعمال الصالحة.
والرحيمية تتضمن مفهوم تدارك النقصان، حيث جاء في الحديث الشريف أنه لولا فضل الله لما نال أحد النجاة.كذلك يتبين من الحديث الشريف أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي :صلى الله عليه وسلم وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اِلله، فوضع يده على رأسه وقَالَ: “وَلَا أَنَا” (البخاري، كتاب الرقاق).
لقد اعترض المسيحيون الأغبياء على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جراء جهلهم وقصور فهمِهم. إنهم لا يفقهون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبّر بقوله هذا عن كمال عبوديته لله تعالى مما جلب له ربوبية الله. لقد جربنا بأنفسنا مرارا، بل نرى ذلك دائما، أنه حين يبلغ تذللنا وتواضعنا منتهاهما وتذوب روحنا بسبب هذه العبودية والتواضع التام وتصل إلى عتبات الله واهبِ العطايا، ينزل نورٌ وضوءٌ من فوق، ويخيل لنا كأن ماء نقيا يصل عبر أنبوب إلى أنبوب آخر.
أنوار وبركات النبي صلى الله عليه وسلم
ففي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حيثما نجد روحه قد بلغت ذروة التواضع والانكسار في مواطن معينة،كان مؤيَّدا ومنوَّرا بتأييد روح القدس ونوره بقدر تواضعه وانكساره. كما دلل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بعَمله وأسوته. إن نطاق أنواره صلى الله عليه وسلم وبركاته واسع جدا بحيث نرى نماذجها وأظلالها متجلية إلى أبد الآباد، فكل هذه الأفضال والفيوض الإلهية التي تنزل علينا في هذا العصر أيضا إنما تتيسر بطاعته واتّباعه صلى الله عليه وسلم فقط. وأقول صدقًا وحقًا إن من المحال لأحد أن ينال البّر الحقيقي ويحظى برضا الله حقًّا وينعم بتلك الإنعامات والبركات والمعارف والحقائق والكشوف التي تُنال بعد بلوغ أعلى درجة من تزكية النفس، ما لم يتفانَ في اتّباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يؤكده كلام الله أيضا إذ قال: “قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ” (آل عمران:31) وأنا الدليل العَملي والحيّ على هذا الإعلان الربَّاني. فاعرِفوني من خلال الآيات التي حدّدها القرآن الكريم لأحباء الله تعالى وأوليائه.
باختصار، لقد بلغتْ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذروة حتى لو أمسكت عجوز يده وقف معها وسمع كلامها بإنصات تام، لم يسحب يده ما لم تتركها هي.
الأمر باجتناب صراط المغضوب عليهم والضالين
ثم ورد قول الله تعالى “غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ” إزاء قوله تعالى “مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ”، ومَن اتخذ هذا الدعاء وِردًا نال الفيوض من ينبوعِ “مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ” وهذا الدعاء يعني: أَنْقِذْنا يا مالِكَ يومِ الدين من أن نكون مثل اليهود الذين صاروا في الدنيا عرضة لصنوف البلايا كالطاعون وغيره، وهلكوا نتيجة حلول غضبك عليهم، وَاحِِمنا من أن نَضِلَّ عن سبيل النجاة كما ضل النصارى.
لقد سُِّمي اليهود هنا مغضوبًًا عليهم، لأن العذاب حلّ بهم نتيجة سوء أعمالهم، إذ كذّبوا أنبياء الله الأطهار وغيرهم من الصادقين وآذوهم أذى شديدا.
وجدير بالانتباه هنا أن الله تعالى قد أمر في الفاتحة باجتناب صراط اليهود وخَتَمَ هذه السورة على “الضَّالِّينَ”، أي أَمَرنا باجتناب صراط “الضَّالِّينَ ” فما هو السر في ذلك يا ترى؟ إنما السر أنه كان من المقدر أن يأتي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم زمان يتمسك فيه مَن يتبعون منها سننَ اليهود بظاهر الأمور وسيحملون الاستعارات محمل الحقيقة، وينبرون لتكذيب المبعوث الإلهي الصادق، كما كذّب اليهود عيسى بن مريم. والمصيبة التي حلت باليهود إنما هي أنهم سخروا من التأويل الذي قدمه لهم المسيح وقالوا له: إذا كان الله يريد من هذه النبوءة أنه لن يأتي إلا مثيل إيليا فلماذا لم يصرح بذلك في هذه النبوءة نفسها؟ وإن معارضينا اليوم أيضا يحذون حذوهم ويتّبعون خطاهم تماما، إذ لم يألوا جهدا في تكذيبي وإيذائي حتى أفتوا بقتلي، وأرادوا بشتى الحيل والمكر إهانتي وإجاحتي، ولولا الحكومة البريطانية في هذه البلاد بفضل من الله تعالى لأثلجوا صدروهم بقتلي منذ مدة طويلة. ولكن الله تعالى أخفقهم في كل ما أرادوا، وحقّقَ وعده لي: “والله يعصمك من الناس”.
باختصار، إن فِئة “غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ” المذكورة في هذا الدعاء تشير إلى حالة تلك الفئة من المسلمين الذين سيعارضون المسيح الموعود.
أما كلمة “الضَّالِّينَ” فهي إشارة إلى زمن بعثة المسيح الموعود حيث تبلغ فيه الفتنة الصليبية منتهاها، والجماعةُ التي يقيمها الله تعالى عندها هي جماعة المسيح، ومن أجل ذلك قد سّمى الله المسيحَ الموعود في الأحاديث على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم “كاسِرَ الصليب”، لأن كل مجدد إنما يأتي لإصلاح الفتن الموجودة في عصره. فبالله عليكم، ألا يكشف عليكم التدبر أنه قد استُخدم في هذه الأيام القلم واللسان لتأييد النجاة الصليبية بحماس شديد بحيث لو أنكم تصفحتم تاريخ العالم كله فلن تجدوا نظيرا لهذا الحماس الشديد في تأييد الباطل في أيّ زمن خلا. وما دامت عبارات حماة الفتنة الصليبية قد بلغت منتهاها، وصار التوحيدُ الحقيقيُّ وعفّةُ النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وصدقه وكونُ كتابه من عند الله تعالى هدفًا للظلم والاعتداء، أفلم يكن من مقتضى غيرة الله أن يُنزِل كاسِرَ الصليب الموعود في هذا الوقت؟ هل نسي الله وعده: “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ” (الحجر:9)؟ اعلموا يقينا أن وعود الله صادقة تماما، وقد أرسل نذيرا في الدنيا وفق وعده، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن الله يقبله حتما، ويُظهر صدقه بصولٍ قويٍّ شديدٍ صول بعد صولٍ. الحق والحق أقول لكم لقد جئتكم مسيحا موعودا بحسب وعد الله تعالى، فاقبلوني إن شئتم، أو ارفضوني إن شئتم. ولكن رفضكم لن يغير شيئا، بل سيتم ما أراد الله تعالى حتما، لأنه قد سبق أن قال في “البراهين الأحمدية:” “صدق الله ورسولُه وكان وعدًا مفعولًا”
(جريدة الحكم، بتاريخ 17-9-1901م)

