القدر
قال الإمام المهدي والمسيح الموعود ميرزا غلام أحمد عليه السلام:
القدر نوعان: معلَّق ومبَرم. والمعلّق يمكن أن يزول بالدعاء والصدقات، ويبدل الله تعالى قدره هذا بفضله، أما المبَرم فلا ينفع فيه الدعاء والصدقات شيئا، غير أن تلك الصدقات والدعوات لا تذهب سدى، لأن ضياعها يتنافى مع عظمة الله تعالى، بل يُري الله تعالى الإنسان تأثير ونتائج أدعيته وصدقاته تلك بشكل آخر. وأحيانا يؤجل الله قدره ويؤخره إلى وقت آخر.
ونجد أصْل القضاء المعلق والقضاء المبرم في القرآن الكريم، وهذا الذكر لم يرد نصًا بل ورد معنى، حيث قال الله تعالى: “ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ” (غافر:61) فيتبين من هنا أن الدعاء يمكن أن يجاب وأن العذاب يمكن أن يلغى بالدعاء. ليس آلاف الأعمال بل كل الأعمال يمكن أن تُنجَز بالدعاء. اعلموا أن الله يتصرف في الأشياء كلها تصرُّفَ قدرةٍ وسلطانٍ، ويفعل ما يشاء. وسواء اطّلع الناس على هذه التصرفات الإلهية الخفية أم لا، إلا أن الخبرات الواسعة لآلاف الناس والنتائج الصريحة لأدعية آلاف الداعين بحرقة وألم، تدلُّ على أن لله تصرفًا خفيًّا في الأشياء، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. وليس لزاما علينا أن نتعمّق في تلك التصرفات لإدراك كُنْهِها وكيفيتها. ما دام الله يعلم أن أمرًا ما آتٍ، فلا حاجة بنا للخوض في الخصام والجدال حوله. لقد جعل الله قضاءه وقدره المتعلق بالإنسان مشروطا بحيث يمكن أن يلغى بالتوبة والخشوع والخضوع. عندما يصاب الإنسان بأذى ومصيبة فإنه يتوجه إلى الأعمال الحسنة فطرةً وطبعًا، ويشعر بداخله بقلق وكرب ينبّهه ويجذبه إلى فعل الحسنات ويُبعِده عن الآثام. وكما أننا نجد تأثير الأدوية بالتجربة، كذلك حين يخرُّ المضطرُّ على أعتاب الله بغاية التذلل والتفاني، ويناديه: ربي ربي، ويدعوه ويستغيثه، فإنه يتلقى البشارة والطمأنينة عبر الرؤى الصالحة أو الإلهامات الصحيحة. قال سيدنا علي -رضي الله عنه- الدعاء الذي يتمّ بصبر وصدق إذا بلغ المنتهى استُجيبَ . وزوال العذاب بالدعاء والصدقة حقيقة ثابتة قد أجمع عليها المئة ألف وعشرين ألف نبّي، وشهد عليها ملايين الصلحاء والأتقياء وأولياء الله تعالى.
جُعلت اللذة والسرور في العبادات
ما هي الصلاة؟ إنها دعاء خاص، ولكن الناس يعدّونها كضريبة الملوك. إن هؤلاء الحمقى لا يفكّرون أيُّ حاجة لله إلى هذه الأمور، وأي حاجة لله مع استغنائه الذاتي لأن يقوم المرء بالدعاء والتسبيح والتهليل له؟ كلا، إن الصلاة إنما هي لمنفعة الإنسان نفسه، حيث يحقق مطلبه خلالها. يؤسفني أن الناس في هذه الأيام لا يحبون العبادات والتقوى والصلاح. وسبب ذلك هو التأثير العام السامّ للتقليد، وهذا ما جعل حبَّ الله يبرد في القلوب، فلا يجدون في العبادة المتعة التي ينبغي أن يجدوها. ليس في الدنيا شيء يخلو من لذة ونوع خاص من المتعة. إن المريض لا يقدر على الاستمتاع بأطيب طعام وأشهاه، بل يجده مُرًّا ويرميه بعيدا، لذا فينبغي لهؤلاء الذين لا يجدون في عبادة الله لذة ومتعة أن يهتموا بمرضهم، لأنني كما قلت من قبل ليس في الدنيا شيء إلا وجعل الله فيه لذة ومتعة. لقد خلق الله تعالى الناس لعبادته، فلماذا لا يجد بعضهم فيها لذة وسرورا. إن في العبادة لذة وسرورا بكل يقين وتأكيد، شريطة أن يكون المرء مستعدًّا للاستمتاع بها. قال الله تعالى: “وَمَا خَلَقْتُ الِْجنَّ وَالِْإنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ” (الذاريات:56)، وما دام الإنسان لم يُخلَق إلا للعبادة، فكان لزاما أن تودعَ العبادة لذةً وسرورا إلى أقصى الحدود. ونستطيع إدراك هذا الأمر بمشاهداتنا وتجاربنا اليومية. وعلى سبيل المثال، قد خُلقت الغلال والمأكولات والمشروبات لفائدة الإنسان، أفلا يجد فيها المتعة واللذة؟ ألا يوجد في فمه لسان يتلذذ بما في هذه الأشياء من طعم ولذة؟ ألا يستمتع برؤية شتى الأشياء الجميلة من نبات وجماد وحيوان وإنسان؟ ألا تستمتع آذانه بأصوات عذبة جميلة؟ فأي دليل يريد بعد ذلك على وجود المتعة في العبادة؟ قال الله تعالى أننا قد خلقنا الرجل والمرأة زوجين، وجعلنا الرجل يميل إلى المرأة، ولم يفعل الله ذلك جبًرا وقهرًا، بل جعل في هذا الميلان أيضا لذة ومتعة، ولو كان الهدف من اجتماعهما التوالد والتناسل فقط لما تحقق هذا الهدف، ولم ترضَ غيرتُهما بالاجتماع عاريين، ولكن يوجد في اجتماعهما متعة ولذة أيضا، حتى إن بعض قصيري النظر لا يهتمّون بالأولاد، بل يهتمون بهذه المتعة واللذة فقط. كانت غاية الله أن يخلق البشر، فأنشأ هذا الاجتماع بين الرجل والمرأة تحقيقا لهذه الغاية، وجعل فيه المتعة ضمنيا، ولكن أكثر الحمقى قد جعلوا المتعة هي الغاية المنشودة وراء ذلك.
فاعلموا جيدا أن العبادة ليست عبئًا ولا ضريبة، بل يوجد فيها أيضا لذة وسرور، وهذه المتعة أسمى وأعلى من كل الملذات المادية والمتع الدنيوية. وكما أن هناك متعة في اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يستمتع بها إلا صاحب القوى السليمة، حيث لا يجدها العِنِّيُن والمخنَّث، أو كما أن المريض يظل محروما من اللذة ولو أكل أطيب الأطعمة وأشهاها، كذلك تماما فإن الشقيّ لا يجد المتعة في عبادة الله.
حقيقة العلاقة بين العبودية والربوبية
إن العلاقة بين الرجل والمرأة عابرة فانية، وأقول إن العلاقة الحقيقية الأبدية ذات اللذة المتجددة إنما هي العلاقة بين الله والإنسان. إنه لمما يصيبني باضطراب شديد وكرب عظيم ينخر نفسي برؤية أن الإنسان عندما لا يجد في الطعام لذةً يذهب إلى الطبيب ويتوسل إليه ويتزلَّف إليه بشتى الطرق، وينفق أموالا طائلة ويقاسي صنوف الآلام ليجد تلك اللذة الموجودة في الطعام، وأن العِنّين الذي لا يقدر على الاستمتاع بزوجته، يصاب بقلق شديد حتى يريد الانتحار أحيانا، وكثيرا ما تقع مثل هذه الوفيات، لكن آهًا لذلك الشقي ذي القلب المريض الذي لا يجد المتعة في العبادة ثم لا يسعى للعلاج. لماذا لا تزهق نفسه حزنًا وألما؟ إنه كم يتكبد العناء من أجل الدنيا ومسرّاتها، ولكن لا يوجد عنده نفس العطش والالتياع من أجل الراحة الحقيقية الأبدية. فيا لحرمانه ويا لشقاوته! يبحث عن العلاج من أجل المتع الآنية الفانية فيجِدُها، فكيف يمكن ألا يوجد ثمة علاج من أجل اللذة الدائمة الأبدية. إن علاجها موجود يقينا، ولكن البحث عنه يتطلب صبرا وثباتا.
لقد ضرب الله تعالى في القرآن بعض النساء مثلًا للصالحين، وفي ذلك سرٌّ وحقيقة. ضرب الله للمؤمنين مثال مريم وآسية، ليبين أنه تعالى يخلق من المشركين مؤمنين. باختصار إن في ضرْب مثالِ النساء سرًّا لطيفا، وهو أنه كما أن هناك علاقة بين المرأة والرجل،كذلك ثمة علاقة بين العبودية والربوبية. فلو كان بين الزوجين حب ووئام، كان زواجهما مباركا ونافعا، وإلا تفكّك نظام بيتهما ولم تتحقق الغاية المتوخاة من زواجهما، وفسَد الرجل نتيجة الارتباط بالنسوة الأخريات ورجع بأنواع الأسقام والأمراض، وأصيبَ بالجذام نتيجة مرض الزهري وأصبح من المحرومين الأشقياء في هذه الدنيا نفسها، ولو وُلد في بيته أولاد، ظل هذا المرض ينتقل إلى أجيال وأجيال. وأما امرأته فتأتي بالفاحشة وتلطخ شرفها وعزتها، ولا تُنال الراحة الحقيقية بتلطيخ الشرف. فكم من عواقب وخيمة تترتب على انفصال الزوجين، كذلك تماما يصبح الإنسان مجذوما ومخذولا جراء انفصاله عن الزوج الروحاني سبحانه وتعالى، ويكابد من الآلام والمحن أشد مما يكابده الزوجان الماديان. فكما أنه توجد في زواج الرجل والمرأة متعة لبقاء النسل، كذلك توجد في علاقة العبودية والربوبية متعة من أجل البقاء الروحاني الأبدي. وقد قال الصوفية: مَن حظي بهذه المتعة آثرَها على سائر ملذات الدنيا ومُتعها، ولو جرّبها مرة واحدة في الحياة كلها لفني فيها. ولكن المشكلة أن كثيرا من الناس في الدنيا لم يدركوا هذا السر، فتكون صلواتهم مجرد نقرات. يقومون ويقعدون في الصلاة بقلب راغب عنها منقبضين ومتضايقين. ومما يبعثني على الأسف الأشد أنني أرى بعضهم لا يصلّون إلا ليزدادوا احترامًا وعزًّا عند أهل الدنيا، وبالفعل ينالون بصلاتهم بُغيتهم هذه، أعني أنهم يُعَدّون من المصلِّين والصالحين، وإنني أتساءل: لم لا يفكرون أنهم ما داموا قد نالوا هذا العز والاحترام بصلاتهم التي صلوها كذبًا وريًاء وبقلوب راغبة عنها، فكم سينالون من العز والدرجة لو صلّوا وعبدوا بصدق القلب؟
سبب عدم التمتع بالصلاة وعلاجه
باختصار، أرى أن الناس يغفلون عن الصلوات ويتكاسلون فيها لأنهم غير مطّلعين على ما أودعها الله من لذة ومتعة. هذا هو السبب الأكبر لذلك. وأهل المدن والقرى أشد كسلًا وغفلة فيها حتى إن الخمسين بالمائة منهم أيضا لا يحنون رؤوسهم أمام مولاهم الحق بنشاط كامل وحب صادق. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا؟ إنما جوابه أنهم غير مطلعين على لذة الصلاة، ولم يذوقوا حلاوتها قط. أما الأديان الأخرى فليس فيها مثل هذه الأحكام. في بعض الأحيان يكونون مشغولين بأعمالهم، وينادي المؤذن ولكنهم لا يريدون سماع ندائه، وكأن قلوبهم تتأذى منه. إن حالتهم يرثى لها جدا. يوجد هنا أيضا أناس دكاكينهم تقع تحت المسجد، ومع ذلك لا يأتون حتى للوقوف فقط في الصلاة. لذا أود أن أقول إن على المرء أن يدعو الله تعالى بمنتهى الحرقة والحماس ويقول: رب كما أذقتنا صنوف اللذة بالثمار وغيرها من النعم، فأذِقنا مرةً لذةَ العبادة والصلاة أيضا. إن ما يؤكَل لا يُنسى. ولو رأى المرء جميلا واستمتع بجماله فإنه يتذكّرَ جماله دوما، وإذا رأى دميما كريه المنظر وأمعن النظر فإنه يتجسد له بكل ملامحه الكريهة كلما تذكره، أما إذا لم يكن له به علاقة ونظر إليه عابرا فلا يحفظ من جماله أو دمامته شيئا.كذلك فإن الصلاة ضريبة عند الذين لا يصلّونها، إذ يرون أن أداءها يضطرهم لأن يستيقظوا من نومهم المريح في الصباح الباكر وأن يتوضأوا في برد قارس تاركين أنواع الراحة. الحق أن مثل هذا الإنسان متضايق من الصلاة، فلا يعرف قدرها. إنه غير مطلع على اللذة والراحة الكامنة في الصلاة، فأنّى له أن يستمتع بها؟ أرى أن مدمن الخمر إذا لم يجد متعة بشرب قليل منها يشرب كأسا تلو كأس إلى أن يشعر بالسكر والنشوة. وبوسع العاقل الفطن أن ينتفع من هذه الظاهرة، أعني يجب عليه أن يداوم على الصلاة ولا ينقطع عنها إلى أن يجد المتعة فيها. وكما أن في ذهن مدمن الخمر هدفًا ينشده وهو أن يجد المتعة بشربها، كذلك على المصلي أن يركز ذهنه وكل ما فيه من قوى على نيل تلك المتعة المودعة في الصلاة، ثم يجب أن يدعو الله تعالى بصدق القلب وكامل الإخلاص والحماس لنيل تلك اللذة -شأن شارب الخمر- في قلق واضطراب وكرب من أجل نشوته، فإني أقول والحق أقول إنه سيجد في الصلاة المتعة والحلاوة حتما ويقينا. ثم يجب أن ينشد في صلاته تلك المنافع التي تتحقق بها. كما عليه أن يراعي الإحسان حيث قال الله تعالى: “إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ” (هود:114)، فعليه أن يدعو الله تعالى في الصلاة -آخذا هذه الحسنات واللذات في الحسبان- بأن يوفقه لصلاة الصِّدّيقين والمحسنين.
لقد قال الله تعالى هنا: “إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ” (هود:114)، أي أن الأعمال الحسنة أو الصلوات يقضين على السيئات، وقال في موضع آخر: “إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ” (العنكبوت:45)، ولكنا نرى البعض يعملون السيئات مع أنهم يصلّون! لماذا؟ والجواب أنهم يصلّون، ولكن بدون الروح والصدق، وإنما ينقرون نقرات تقليدا وعادة فحسب، وأرواحهم ميتة، ولم يسمّ الله تعالى صلاتهم حسنات. والجدير بالذكر أن الله تعالى قال هنا: “الَْحسَنَات” ولم يقل: “الصلاة”، مع أن المعنى واحد، ذلك ليشير الله إلى ما أودعه في الصلاة من ميزة وحسن وجمال، وليبين أن الصلاة التي تتّسم بروح الحق وفيض التأثير تُذهب السيئات حتما ويقينا. الصلاة ليست اسما للقيام والقعود، بل إن مّخها وروحها هو ذلك الدعاء المقرون بلذة وحلاوة.
حقيقة أركان الصلاة
إن أركان الصلاة إنما هي القيام والقعود الروحانيان. على الإنسان القيام أمام الله تعالى، وهو من آداب الخدمِ. أما الركوع، أي الجزء الثاني من الصلاة، فهو يوحي بمدى استعداد المرء لإخضاع عنقه للعمل بالأمر الإلهي. وأما السجود فيدل على منتهى الأدب والتذلل والفناء الذي هو هدف العبادة. فهذه آداب وطرق وضعها الله تعالى في الصلاة ليذكِّر الإنسان بهدفه وليعطيه نصيبا من السلوك الروحاني. وإضافة إلى ذلك فقد جعل الله تعالى هذه الطريقة الظاهرية إثباتًا للطريقة الباطنية الروحانية. ولو قام المرء بالطريقة الظاهرية -وهي انعكاس للطريقة الباطنية الروحانية- مقلدا الآخرين تقليدًا فارغًا، ومحاولًا التخلص من الصلاة كأنها عبء ثقيل، فأية متعة أو لذة يمكن أن يجدها فيها، وكيف تتيسر له حقيقة الصلاة بدون نيل الحلاوة والمتعة فيها؟ إنما يتأتى له هذا حين تخرّ روحه أيضا على عتبة الله تعالى بكامل الفناء وكامل التذلل، وتردِّدُ روحه ما يردّده لسانه. عندها يحظى بسرور ونور وسكينة.
أود أن أوضح هذا الأمر بمزيد من البيان، أعني أن على الإنسان أن يعترف بربوبية الله في جميع المراحل التي مرَّ بها في مختلف الأوقات إلى أن صار إنسانًا، أعني بدءًا من مرحلة النطفة، بل من مرحلة عناصر النطفة المختلفة من شتى الأغذية وكيفيةِ تكوُّنها، ثم المراحل التالية للنطفة من طفولة وشباب وشيخوخة. يجب أن يعترف بربوبية الله في جميع تلك المراحل التي مر بها مستحضرا إياها في الصلاة كل حين، وعندها فقط سيتمكن من طرح عبوديته أمام ربوبية الله تعالى.
باختصار، إنما تتيسر لذة الصلاة وحلاوتها نتيجة الاتصال بين العبودية والربوبية. فما لم يِّخر العبد أمام الله تعالى معتبرا نفسه كالمعدوم تماما أو شبه معدوم كما هو مقتضى الربوبية، لا ينزل عليه فيض الربوبية ولا يُظله ظلها. ولو قام بذلك في الصلاة لنال متعةً ما بعدها متعة.
الصلاة الحقيقية
في هذا المقام تصبح روحُ الإنسان كالمعدوم تماما، وتسيل إلى الله تعالى كعين جارية، وتنقطع عمّا سوى الله كلية، وتنزل عليه محبة الله تعالى، وباتصال هذين الهياجين، هياجِ الربوبية مِن فوق وهياج العبودية مِن تحت، تتولد حالة خاصة تسمَّى الصلاة. وتلك الصلاة هي التي تحرق السيئات وتغادرها رمادًا، وتترك وراءها نورًا ولمعانًا ينفع السالك كمصباح منير عند صعوبات الطريق وشدائده، وينّبهه ويقيه من كل العوائق والعثرات التي تعترض طريقَه من عشب وشوك وحجر وما إلى ذلك. هذه هي الحالة التي يصدُق عليها قول الله تعالى: “إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ” (العنكبوت:45)، لأن سراجًا منيرا يكون في قلبه، لا في يده. وهذا المقام لا يُنال إلا بالتذلل الكامل والفناء الكامل والتواضع الكامل والطاعة الكاملة، وأنى لمن بلغ هذا المقام أن يفكّر في الإثم. كلا، بل يستحيل أن ينشأ فيه الإنكار والعصيان، ويرتفعَ بصره إلى الفحشاء. باختصار، يتيسر له من اللذة والسرور ما لا أراني قادرا على وصفه.
الميل إلى غير الله تعالى
وجدير بالتذكر أيضا أن هذه الصلاة التي هي الصلاة حقًّا إنما تتيسر من خلال الدعاء نفسه. إن سؤال غير الله تعالى ينافي غيرةَ المؤمن منافاة شديدة وصريحة، لأن الدعاء خاص بالله وحده. واعلموا أن الإنسان ما لم يسأل الله تعالى ويدعوه هو وحده حنيفًا تمامَ الحنفية، لا يستحق أن يُدعى مسلما صادقا ومؤمنا مخلصا. إنما حقيقة الإسلام أن يخرّ الإنسان على العتبة الإلهية بجميع كفاءاته وقدراته، سواء الباطنية أو الخارجية. فكما أن المحرّك الكبير يحرك أجهزة كثيرة، كذلك ما لم يجعل الإنسان كل عمل وحركة وسكون له تابعة لقوة ذلك المحرّك العظمى، فأنّى له أن يؤمن بألوهية الله حقا، وأنّى له أن يسمي نفسه حنيفًا في الحقيقة حين يقول: “إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا” (الأنعام:79)، من كان قلبه أيضا متوجها إلى الله تعالى كما يردده لسانه، فلا جرم أنه مسلم ومؤمن وحنيف، أما الذي يسأل غيَر الله ويجنح إلى غيره أيضا، فليعلم أنه شديد الشقاوة والحرمان، وسيأتي عليه وقت لن يقدر فيه على التوجه إلى الله ولو باللسان رياءً.
ومن دواعي ترك الصلاة والكسل فيها أن الإنسان إذا مال إلى غير الله تعالى ظلّت روحه وقواه القلبية مائلة إلى ما سوى الله تعالى، ويقسو قلبه تجاه الله تعالى، حتى يصبح جامدا كالحجر، شأن الشجرة المنثنيةِ أغصانُها إلى ناحية منذ نعومتها، فنمتْ وكبرت مائلةً إلى تلك الناحية، وكما أن ثَنْي تلك الأغصان إلى ناحية أخرى مستحيل بعد ذلك، كذلك ليس بوسع هذا الإنسان أن ينثني إلى الله تعالى، فيظل قلبه وروحه يبتعدان عن الله تعالى يوما فيوما. فأَنْ يترك الإنسانُ الله تعالى ويسأل سواه لأمرٌ جد خطير ومرجف للقلب، لذا فإن مداومة المرء على الصلاة والتزامه بها ضروري جدا، لكي تصبح الصلاة عادة راسخة فيه ويفكّر في الرجوع إلى الله تعالى أولًا، ثم بعد ذلك يأتي تدريجيا ذلك الوقتُ الذي يرث فيه نورًا ومتعة منقطعًا إلى الله تعالى انقطاعا كليا.
وها إني أؤكد هذا الأمر ثانيةً، ومن المؤسف أني لم تسعفني الكلمات المناسبة لبيان مساوئ الرجوع إلى غير الله تعالى. يذهب الناس إلى الآخرين ويتوسلون إليهم متملقين، وهذا التصرف يثير غيرة الله، لأن تصرفهم هذا هو بمنزلة العبادة والصلاة للناس، ولذلك فإن الله تعالى ينأى عن مثل هذا الإنسان ويرميه عنه بعيدا.
وأضرب لبيان هذا الأمر مثالا، ولكنه ليس حقيقة بل هو مجرد مثال يبين هذا الأمر جيدا، وهو: كما أن الإنسان الغيور لا يطيق رؤية زوجته وهي في علاقة غير مشروعة مع شخص آخر، وتستوجب هذه المرأة الخبيثة القتل في رأيه، وكثيرا ما يقع القتل في مثل هذه الحالات بالفعل، كذلك تكون غيرة الألوهية وحماسها تجاه العبودية. إن العبودية والدعاء خاص بالله تعالى، فلا يرضى أن يُتخذ غيُره إلهًا أو يُدعى من دونه. ألا فاسمعوا وعوا جيدا: إن الميلان إلى غير الله يعني قطع العلاقة مع الله تعالى.
إن الصلاة -أو التوحيد بتعبير آخر؛ لأن إقرار التوحيد عمليًا هو الصلاة في الواقع- يظلّ صاحبها محروما من بركتها وفوائدها ما دام لم يصلّها بروح الفناء والتذلل وبقلب حنيف.
الأخذ بالأسباب شعبة من شعب الدعاء
ألا إن الدعاء الذي قال الله عنه: “ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ” (غافر:60)، يتطلب روحًا صادقة، أما إذا كان التضرع والخشوع خاليا من الحقيقة فلا يعدو الأمرُ ترديدَ الكلمات كالببغاء.
وقد يقول البعض أن لا حاجة للأخذ بالأسباب. وهذا القول ناشئ عن سوء فهمٍ، فإن الشريعة لم تمنع من الأخذ بالأسباب. والحق يقال: أليس الدعاء نفسه أحد الأسباب؟ أوليست الأسباب من قبيل الدعاء؟ الحق أن البحث عن الأسباب بحد ذاتها دعاءٌ، والدعاء في حد ذاته مصدر لأسباب عظيمة! إن خلْق الإنسان الظاهريّ وبنْية يديه وقدميه كلها لدليل طبعي على التعاون المتبادل. وما دام هذا المشهد موجودا في الإنسان نفسه، فمن المدهش أن يصعب على المرء فهمُ معاني قوله تعالى: “تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِِّر وَالتَّقْوَى” (المائدة:2).
غير أني أقول: ابحثوا عن الأسباب أيضا بواسطة الدعاء. ما دمتُ قد بينت لكم ما خلقه الله تعالى في أجسادكم من نظام متكامل مرشد إلى ضرورة التعاون المتبادل، فلا أدري كيف يمكنكم إنكار الدعاء. ولتبيانِ ضرورة الأخذ بالأسباب بصورة أجلى قد أقام الله تعالى نظام بعثة الأنبياء في الدنيا. كان الله تعالى، ولا يزال، قادرا على ألا يجعل أنبياءه عليهم السلام بحاجة إلى أيّ استعانة من الناس لو شاء ذلك، ومع ذلك يأتي على الأنبياء وقت يضطرون فيه للقول: “مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله” (آل عمران:52) فهل تظنّون أن نداءهم هذا يكون كنداء المتسولين العاجزين؟ كلا، بل إن قولهم: “مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله” متّسم بالعظمة. إذ يريدون أن يعلّموا الناس ضرورة الأخذ بالأسباب الذي هو شعبة من شعب الدعاء، وإلا فإنهم يؤمنون بالله إيمانا كاملا ويوقنون بوعوده يقينا تاما، ويعلمون أن وعد الله “إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الَْحيَاةِ الدُّنْيَا” (غافر:51)وعدٌ يقيني ومبرم. يا ترى،كيف ينصرهم أحد إذا لم يُلقِ الله في قلبه فكرة نصرتهم؟
السر في دعوة المأمور الرباني الناس لنصرته
الحق أن المعين النصير الحقيقي هو الله وحده الذي صفته: “نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيُر” (الأنفال:40) عند هؤلاء القوم تكون الدنيا ونصرته كالميت، ولا تساوي دودةً ميّتة، إلا أنهم يتبعون هذا الأسلوب لتعليم الناس ضرورة الدعاء بهذا المثال الواضح. الحق أنهم يرون الله وحده كافلَ، وهذا هو الأمر الواقع: “وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِِحيَن” (الأعراف:196)، ولكن الله تعالى يأمرهم بإنجاز مهمتهم بواسطة الآخرين. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لنصرته في مناسبات شتى، ذلك لأن الوقت كان وقت النصرة الإلهية، فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى ويبحث عمن تتحقق نصرة الله على يده. إن هذا لأمرٌ جدير بالتأمل. الحق أن المأمور الإلهي لا يستعين بالناس، بل يريد استقبال النصرة الإلهية بقوله: “مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله” (آل عمران:52)53، ويظل يبحث عنها بقلب مضطرب من فرط الشوق. يظن الأغبياء قليلو البصيرة أنه يطلب المعونة من الناس، والواقع أنه باتخاذ هذا الأسلوب إنما يتسبب في نزول البركة والرحمة على قلب يصبح وسيلة لهذه النصرة. فهذا هو السر الحقيقي الكامن وراء استعانة المأمور الربَّاني بالناس، وسيظل هذا الأمر هكذا. لا شك أن المأمورين الربَّانيين يطلبون المعونة من الناس في سبيل نشر دينهم، ولكن لماذا؟ لأداء واجبهم، ولتوطيد عظمة الله في القلوب، وإلا فيكاد الأمر يكون كفرًا لو عدّوا ما سوى الله تعالى كافلَ أمرِهم. وهذا محال على الإطلاق من هؤلاء النفوس القدسية. لقد قلت آنفًا إن التوحيد الكامل لا يتيسر للمرء إلا باعتباره الله الأحد معطيَ كل شيء ودواءَ كل داء وعمادَ كل أمر. هذا هو معنى “لَا إِلَهَ إِلَّا الله” وقد فسر الصوفية لفظ الإله بمعنى المحبوب والمقصود والمعبود. وهذا هو الحق صدقًا وعدلا. فما لم يتمسك الإنسان بالتوحيد تمسكا كاملا، لا تتوطد فيه محبة الإسلام وعظمته.
وأعود إلى الموضوع الأصلي ثانية وأقول إن لذة الصلاة وحلاوتها لا تتيسر لمثِل هذا الإنسان. فما لم يحرق الإنسان نواياه السيئة وخططه الخبيثة القذرة وما لم يتفان ويتواضع بالقضاء على أنانيته وكبريائه، لن يسمى عبد الله الصادق، وإن أفضل معلم وخير وسيلة لتعليم العبودية الكاملة إنما هي الصلاة نفسها.
وها إني أقول لكم مرة أخرى إن كنتم تريدون إنشاء صلة حقيقية وعلاقة صادقة مع الله تعالى فداوموا على الصلاة والتزموا بها بحيث تصبح إراداتُ روحكم وجذباتها، فضلًا عن أجسادكم وألسنتكم، كلُّها صلاةً متجسدة.
(جريدة الحكم، بتاريخ 12-4-1898م)
هذا هو السر الكامن في عصمة الأنبياء. لماذا يكون الأنبياء معصومين؟ إنما يحظون بالعصمة لاستغراقهم في حبّ الله تعالى. إنني أستغرب جدًّا حين أرى الأمم المتورطة في الشرك، كالهندوس الذين يعبدون أنواع الأصنام حتى أجازوا عبادة الأعضاء الجنسية للرجل والمرأة، أو الذين يعبدون إنسانا ميتا، أعني يسوعَ المسيحَ. يعتقد أمثال هؤلاء بالفوز بالنجاة بسبل شتى، فالقسم الأول منهم، أي الهندوس، يريدون النجاة من خلال الاغتسال في نهر الغانج وزيارة معابد معينة، وينشدون غفران الذنوب بكثير من الكفارات من هذا القبيل. أما المسيحيون، عبَدةُ عيسى، فيرون في دم المسيح فديةً لذنوبهم. ولكنني أقول: ما دام الذنب موجودا فيهم فأنّى لهم أن ينالوا الراحة أو الطمأنينة بهذه الطهارة الظاهرية والمعتقدات الخارجية. من المستحيل أن يفوز الإنسان بالطهارة الحقة التي تُنال بها النجاة ما لم ينظف داخله ويطهر باطنه. نعمْ، يمكنكم أنتم أن تتعلَّموا مِن ذلك درسًا، فكما أنكم ترون أن درن الجسم وعفونته لا يزولان من دون الغسل، ولا يكون البدن معها في مأمن من الأمراض الخطيرة المهددة، كذلك فلا يزول الوسخ والدرن الروحاني المتراكم على القلوب بارتكاب أنواع المنكرات والجسارات ما لم يغسله ماءُ التوبة المصفى الطاهر. فكما أن هناك فلسفةً في النظام المادي، كذلك هناك فلسفة في النظام الروحاني أيضا. فطوبى للذين يتدبرون في ذلك ويتفكرون.
حقيقة الإثم ووسائل النجاة منه
وأود هنا أيضا أن أخبركم لماذا ينشأ الإثم. والجواب بكلمات سهلة هو أن حب غير الله حين يستولي على قلب الإنسان، فإنه يصيب تلك المرآة الصافية النقية بنوع من الصدأ، حتى يسودّ كله رويدا رويدا، وتعشش فيه الغيريّةُ وتُبْعِده عن الله نهائيا. وهذا هو أصل الشرك. أما القلب الذي تستولي عليه محبة الله، ومحبةُ الله وحده، فهي تحرق ما فيه من الغيريّة وتصطفيه لها وحدها، وعندها تنشأ فيه الاستقامة وتستوي في مقامها الحقيقي. لا شك أن الإنسان يتألم حين ينكسر عضو من أعضائه ثم حين يُجبَر، لكن ألم الكسر يكون أكبر كثيرا من ألم عملية الجبر، ثم إن ألم عملية جبره يكون مؤقتا وجالبًا للراحة فيما بعد، ولكن العضو الكسير لو بقي على حاله اضطر المرء لبتِره أيضا في نهاية المطاف. وبالمثل، فإن نيل الاستقامة يُحَتّم مواجهةَ شيء من الأذى والصعاب في المراحل والمدارج الابتدائية، لكن بعد نيل الاستقامة ليس إلا الراحة والسرور الدائمان.
ورد أنه لم تكن لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّ شعرة بيضاء قبل أن يتلقى أمر الله تعالى: “فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ” (هود:112)، ولكن بعدها بدأ شعرُه يبيضّ ، حتى قال: “شيَّبتْني هودٌ” (الترمذي).
باختصار، لا يستطيع الإنسان أن يميل إلى الحسنات ما لم يكن عنده الإحساس بالموت. لقد أخبرت أن الإثم ينشأ بنشوء حب غير الله في القلب، ويستولي عليه بالتدريج؟ فمن وسائل اجتناب الإثم والاعتصام منه أن يذكر الإنسان الموت دوما، ولا يبرح يتدبر عجائب قدرة الله، لأن ذلك يزيده إيمانًا وحبًا لله تعالى، وإذا نشأ حب الله في القلب حرق الإثم وحوّله رمادا.
فالوسيلة الثانية لاجتناب الإثم هي الإحساس بالموت. فلو وضع المرء موته في الحسبان كل حين، لكفَّ عن هذه السيئات والخطايا، وتيسر له إيمان جديد بالله تعالى، وتسنتْ له فرصة التوبة والندم على ذنوبه السابقة.
ما حقيقة هذا الإنسان الضعيف؟ إنما تتوقف حياته على نَفَسٍ واحدٍ فقط. فلماذا إذن لا يهتمّ بالآخرة، ولا يخاف الموت، ولماذا يضيع العمر خادمًا منقادًا للعواطف النفسانية والحيوانية؟ لقد رأيت أن الهندوس أيضًا قد نشأ لديهم الإحساس بالموت. كان في بطالة ثريٌّ يُدعى كشن جند، وكان عمره يتراوح ما بين 70 و 72 عاما، فهجر البيتَ والأهل وكل شيء، وذهب ليسكن في “كانشي”، وهنالك مات. ولم يفعل ذلك إلا ظنًّا منه بأن موته هنالك سيُكسبه النجاة. لا شك أن ظنه هذا كان باطلا، غير أننا نتوصل من ذلك إلى نتيجة مفيدة وهي أن الرجل كان عنده الإحساس بالموت، وأن الإحساس بالموت يعصم الإنسان من الانغماس كليةً في ملذات الدنيا ومن الابتعاد عن الله نهائيا. وليس الظنُّ بأن الموت في كانشي مدعاة للنجاة إلا غشاءَ عبادةِ المخلوق الذي كان على قلب ذلك الهندوسي.
غير أنني أتأسف جدًّا حين أرى أن المسلمين ليس عندهم الإحساس بالموت حتى كالهندوس أيضا. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف شيّبه أمرٌ رباني واحد: “فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ” (هود:112). كم كان إحساسه بالموت قويا لماذا صارت حالته هكذا؟ ليس إلا لنأخذ من ذلك درسا وعبرة، وإلا فقد بلغت حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الطهر والقداسة أنْ جعَله الله تعالى هاديا كاملا إلى يوم القيامة وللعالم بأسره. ذلك لأن سوانح حياته كلها كانت مجموعةً للأحكام العَملية. فكما أن القرآن الكريم كتاب الله القولي، وقانونَ الطبيعة كتابُ الله العملي، كذلك فإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكتاب العملي، وكأنما هي شرحٌ وتفسير للقرآن الكريم. لقد ابيضَّ شعري حين كنت في الثلاثين من عمري وكان حضرةُ المرزا، والدي المرحومُ، ما زال حيًّا. فكأنما الشعر الأبيض هو أيضا من أمارات الموت. عندما يغزو الشيبُ الذي علامته هذا الشعرُ الأبيض، يدرك المرءُ أن أيام موته قد اقتربت، ولكن المؤسف أنه لا يهتمّ عندها أيضا. المؤمن بوسعه أن يتعلم الأخلاق الفاضلة حتى من العصفور وغيره من الحيوانات، لأن كتابَ الله المفتوح هذا موضوع أمامه، وكل ما خلقه الله تعالى في الدنيا إنما هو لراحة الإنسان المادية والروحانية كلتيهما. لقد قرأت في تذكرة حضرة جنيد -رحمة الله عليه- أنه قال: لقد تعلَّمت التأمُّل والتدبر من القِطة. لو أمعن الإنسان النظر جيدا لرأى أن الحيوانات أيضا تمتلك الأخلاق بلا مراء. ومذهبي أن كل طير ودابة عبارةٌ عن خُلق، والإنسان اسم لمجموعها. إنه النفس الجامعة، ولذلك يسمَّى العالََم الصغير، إذ توجد فيه كمالاتُ كل المخلوقات مجموعةً. وإن كمالات كافة البشر قد جُمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بُعث إلى العالم أجمعَ، وسُِّميَ رحمةً للعالمين. وإن قول الله تعالى “وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ” (القلم:4) أيضا إشارة إلى مجموعة الكمالات الإنسانية هذه، وهذا ما يساعد على التدبر في عظمة الأخلاق المحمدية، ومن أجل ذلك قد خُتمت على النبي صلى الله عليه وسلم كمالاتُ النبوة الكاملة. فمن المسلَّم به أن خاتمة أي شيء تكون عند بلوغه الغايةَ المتوخاة مِن خلْقه. فكما أن الكتاب إذا تم بيان جميع مضامينه انتهى،كذلك فإن الغاية المتوخاة من النبوة والرسالة قد خُتمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى ختم النبوة، لأن هذه السلسلة كانت جارية عبر العصور، وخُتمت عند الإنسان الكامل.
الاستقامة هي الاسم الأعظم للإنسان
وأود أن أبين أيضًا أن الاستقامة التي بدأتُ بها هذا الموضوع هي نفس ما يسميه الصوفية الفناءَ في مصطلحهم، وهم يفسرون: “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ” أيضا بمعنى الفناء، أي أن تصبح أرواحنا وثوائرنا وإراداتنا كلُّها لله تعالى، وأن تموت عواطفنا وأهواؤنا النفسانية نهائيا. إن بعض الناس الذين لا يؤْثرون مشيئة الله وإراداته على إراداتهم وثوائرهم يغادرون الدنيا في أحيان كثيرة بسبب خيبة آمالهم فيما أرادوا وتمنّوا. كان أخي المرحوم مرزا غلام قادر شديدَ الانهماك في متابعة القضايا، وقد بلغ به استغراقه وانهماكه فيها أن أثّرت خيبة آماله فيها على صحته سلبيًا، فمات. لقد رأيت أناسا آخرين كثيرين يؤْثرون إراداتهم على الله تعالى، وفي نهاية المطاف يفشلون في تقديم هذه الأهواء على مشيئة الله، فيخسرون، بدلًا من الفائدة، خسرانا عظيما. سيكشف لكم التأمل في الإسلام أن سبب الفشل هو الكذب فقط. عندما يقلّ التفات المرء إلى الله تعالى ينزل عليه قهره الذي يجعله خائبا وخاسرا، لا سيما عندما يخلد ذوو البصيرة إلى الدنيا ومآربها بكل حماسهم وإراداتهم، فإن الله تعالى يجعلهم من الخائبين. ولكن السعداء يضعون في الحسبان ذلك المبدأ المقدس، أعني الإحساسَ بالموت. إن السعيد يفكر أنْ لا مناص له أيضا من الموت في يوم من الأيام كما مات والداه أو بعض كبار عائلته، وأحيانا يفكر في عمره ويقول لقد غزاني المشيب والموت قريب الآن، فيرجع إلى الله تعالى. هناك عائلات لا تصل أعمار أبنائها عموما إلا 50 عاما أو 60 عاما. فمثلًا إن أعمار أفراد عائلة السيد ميانْ في بطالة لا تتجاوز هذا الحد عادة. وهكذا فإن تقدير المرء أعمار أفراد عائلته أيضًا يبعثه على الإحساس بالموت. فينبغي أن تضعوا في الحسبان جيدا أنه لا مناص من ترك هذه الدنيا ومُتعها في يوم من الأيام، فلماذا لا يترك الإنسان قبل ذلك الأوان الطرقَ غير الشرعية لنيل هذه المتع. لم يترك الموت كبار الصالحين والمقربين، ولم يبال بالشباب ولا بأكبر الأثرياء أو الأتقياء أيضًا، فلماذا يترككم؟ فاحسبوا الدنيا ومَرافقها سببًا من أسباب الحياة ووسيلةً لعبادة الله تعالى. لقد بيَّن السعدي هذا الموضوع كالتالي:
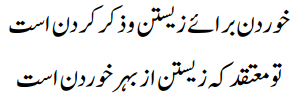
أي: إنما الأكل هو من أجل العيش والذكر، لكنك تعتقد أن العيش من أجل الأكل فقط.
لا تظنوا أن الله سيرضى عنكم حتمًا وأنتم تستمتعون بالملذات. إن هؤلاء العميان لو جاءتهم رسالة من الله فأيضا لن يكفّوا عن الانغماس في المتعة التي يجدونها في الانجرار وراء اتّباع الرغبات الجسدية والنوايا المادية، ويؤْثرونها على المتعة التي ينالها المؤمن في الله تعالى. والحق أن رسالة الله لموجودة، واسمها القرآن الكريم الذي يعِد بالجنة الخالدة والراحة الأبدية، لكن وعْده بالنعم لا يُلتفت إليه مطلقا. كم يتكبد الإنسان الغافل من الآلام والصعاب بحثًا عن الفرحة الوهمية والراحة المؤقتة، ولكنه عند رؤية صعوبة بسيطة في سبيل الله تعالى يصاب بالقلق ويسيء الظن. ليته استطاع تقدير الأفراح الدائمة الأبدية إزاء هذه اللذات الفانية. وللتغلب على هذه الصعاب والمحن هناك وصفة كاملة وناجحة حتمًا قد جربها ملايين الصالحين. فما هي تلك الوصفة؟ ألا إنها الوصفة التي تسمَّى الصلاة.
فما هي الصلاة؟ إنما هي دعاء يحمي المرء من جميع السيئات والفواحش ويجعله مستحقًّا للحسنات ومحطًّا لنعم الله تعالى. لقد قيل إن لفظ الجلالة “الله” هو الاسم الأعظم. لقد جعل الله جميع صفاته تابعة لهذا الاسم. تأملوا هنا قليلا، فإن الصلاة تبدأ بالأذان، والأذان يبدأ ب “الله أكبر”، أي باسم “الله”، وينتهي ب “لا إله إلا الله”، أي باسم “الله” أيضا. إنها لمفخرة العبادة الإسلامية وحدها أن الله وحده، لا غير، هو المقصود في أولها وآخرها. وأقول بكل تحدٍّ لا يوجد هذا النوع من العبادة في أي أمة ولا ملة.
فالصلاة التي هي الدعاء، قد قُدِّم فيها اسم الله الذي هو الاسم الأعظم له سبحانه وتعالى.
كذلك فإن الاستقامة هي الاسم الأعظم للإنسان. والمراد من الاسم الأعظم للإنسان ما تتحقق به الكمالاتُ الإنسانية، وإلى ذلك نفسه قد أشار الله تعالى في قوله: “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ” وقال تعالى في موضع آخر: “إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثَُّم اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تََخافُوا وَلَا تَْحزَنُوا” (فصلت:30)، أي أن الذين جاءوا تحت ربوبية الله تعالى، أي حين توضع البيضة البشرية تحت الاسم الأعظم أيْ الاستقامة، تنشأ فيهم من الكفاءة ما يجعل الملائكة تنزل عليهم، ولا يبقى لهم خوف ولا حزن.
لقد قلت آنفًا إن الاستقامة لشيء عظيم. فما هي الاستقامة؟ اعلموا أن كل شيء إذا كان موضوعًا في محله ومقامه سُّمي الحكمةَ والاستقامة. فمثلا لو قمنا بتفكيك جهاز المنظار وفصْل كل أجزائه التركيبية عن مكانها الأصلي، فلن ينفع أبدًا. فوضْع الشيء في محله هو الاستقامة، أو بتعبير آخر إن الهيئة الطبيعية للشيء هي الاستقامة. وإننا ما لم نترك البنية الإنسانية في وضعها الطبيعي تماما، ولم نضعها في حالة مستقيمة، فمن المستحيل أن تحرز كمالاتها المنشودة. فالأسلوب السليم للدعاء إنما هو أن يجتمع فيه الاسمان الأعظمان، وأن يتوجه الداعي إلى الله تعالى ولا يتوجه إلى أحد غيره، وإن كان هذا الغير وثنَ أهوائه وأطماعه، وعندها يذوق الداعي طعْمَ “ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ” (غافر:60).
فأمنيتي أن تجاهدوا من أجل الاستقامة وتنالوها بترويض النفس، لأن الاستقامة تبلّغ المرء حيث يتشرف دعاؤه بالقبول. يوجد في الدنيا اليومَ كثيرون يشتكون عدم استجابة الدعاء، ولكني أقول مع أسف شديد أَنَّى لهم أن ينالوا متعة استجابة الدعاء ما لم يتحلّوا بالاستقامة. إننا نحظى بآيات استجابة الدعاء في هذه الدنيا نفسها.
بعد الاستقامة يجد الإنسان في نفسه آثار ثلج القلب والسكينة، ولا يحرق قلبه أي نوع من الفشل وخيبة الأمل في بادي الرأي. لكن الذين يجهلون حقيقة الدعاء ينقلب عليهم فشلهم البسيط فيحًا من نار جهنم ويستولي على قلوبهم، ويصيبهم بالحزن والقلق الدائمين، وإلى ذلك قد أشار الله تعالى بقوله: “نَارُ الله الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الَْأفْئِدَةِ” (الهمزة:6-7)، بل يبدو من الحديث الشريف أن الحمَّى أيضًا من نار جهنم.
سلسلة المجددين في الأمة
وهناك أمر آخر جدير بالإنتباه هنا، ألا وهو: لما كان من المقدر أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، ليغيب بذلك عن العالم -في ظاهر الأمر- النموذجُ الذي يُري وجه الله تعالى، فقد دبَّر الله لتلافي ذلك طريقًة سهلة حيث قال: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُِحبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي” (آل عمران:31) ذلك لأن صاحب الاستقامة هو وحده يمكن أن يصبح محبوب الله، ويستحيل أن يصير صاحبُ الزيغ محبوب الله أبدًا. وقد فرض الله علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة لكي يزداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتجدد، لتتيسر لنا وسيلة للاستقامة التي بها يجاب دعاؤنا هذا. فمن المسلم به أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم باق على وجه الظلية إلى يوم القيامة. ويقول الصوفية إن أسماء المجددين تكون على اسم النبي صلى الله عليه وسلم حصرا، أعني أنهم يُعطَون ذلك الاسمَ نفسَه على وجه الظلية بشكل من الأشكال. أما عقيدة الشيعة بأن سلسلة الولاية قد انتهت عند سيدنا علي -رضي الله عنه- فهي باطلة تماما. إن الكمالات التي قد جعلها الله تعالى في النبوة قد خُتمت جميعها على الهادي الكامل صلى الله عليه وسلم، والآن ستظل تلك الكمالات تُلقي فيوضها على العالم على وجه الظلية بواسطة المجددين دوما، فسوف يمدد الله هذه السلسلة إلى يوم القيامة.
أقول مرة أخرى إن الله تعالى لم يحرم العالم في الزمن الحاضر أيضًا، وقد أقام لذلك جماعة. أجلْ، قد أقام الله تعالى بيده عبدًا، وهو نفسُه الذي يكلّمكم جالسًا بين ظهرانيكم. إن هذا الوقت وقت نزول رحمة الله. فادعوا الله تعالى، واسألوه الاستقامة، وأكثِروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وسيلة عظيمة لنيل الاستقامة، لكن لا على سبيل العادة والتقليد فحسب، بل صلّوا عليه واضعين في الحسبان حُسنه وإحسانه صلى الله عليه وسلم، لرفعِ مدارجه ومراتبه ولنجاحاته، وستكون نتيجة ذلك أنكم ستُعطَون الثمرةَ الحلوة اللذيذة لاستجابة الدعاء.
وسائل استجابة الدعاء
وهناك ثلاث وسائل لاستجابة الدعاء:
الأولى: “إِنْ كُنْتُمْ تُِحبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي” (آل عمران:31).
والثانية: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا” (الأحزاب:56).
والثالثة: الموهبة الإلهية، فمن قانون الله العام أنه يخلق في العالم نفوسًا قدسية كثيرة -مثل نفوس الأنبياء- تكون متحليةً بالاستقامة بالفطرة.
اعلموا أيضًا أن الناس ثلاثة أنواع من حيث الفطرة، الأول: ظالٌم لنفسه، والثاني: مقتصد، أي يكون حائزا على شيء من الحسنات ومشوبً بشيء من السيئات أيضًا، والثالث: سابقٌ بالخيرات وكارهٌ للسيئات. وهذه الفئة الأخيرة تبلغ مرتبة الاجتباء والاصطفاء، ومن هذه الفئة الطاهرة تكون جماعة الأنبياء عليهم السلام. وهذا النظام جارٍ ومستمر منذ الأزل، ولم تَْخلُ الدنيا من أمثال هؤلاء قط.
يطلب بعض الناس مني الدعاء، لكنهم للأسف الشديد لا يعرفون آداب طلب الدعاء، وعلى سبيل المثال، إذا احتاج “زيد” إلى الدعاء، أرسلَ “بكرًا” ليطلب له الدعاء. هذا الأسلوب لا ينفع شيئا. فما لم ينشئ طالبُ الدعاء في نفسه القابليةَ ولم يتعود على الاتّباع والطاعة لن يجديه الدعاء نفعًا. إذا كان المريض لا يرى ضرورة العمل بأمر الطبيب فمن المحال أن يستفيد منه شيئا. فكما أن المريض لا بد له من العمل بنصح الطبيب باستقامة وصبر لكي يستفيد منه، كذلك تماما هناك آداب وأساليب لطلب الدعاء أيضًا.
ورد في “تذكرة الأولياء” أن شخصًا طلب الدعاء من أحد الصالحين، فطلب منه الرجل الصالح أن يأتيه بالأرز والحليب. فاندهش السائل، لكنه ذهب وجاء بهما، فدعا له الرجل الصالح وتحقق مراد الطالب. عندها أخبره الرجل الصالح وقال: إنما فعلتُه مِن أجل إنشاء علاقة خاصة بيني وبينك.
كما ورد في تذكرة باوا فريد المحترم أن شخصا فقد مستندا هاما له، فجاء إلى باوا فريد طالبا الدعاء، فقال له أطعمْني الحلوى أولًا. فذهب الرجل لشراء الحلوى، فوجد مستنده الهام بين الأوراق في محل الحلواني.
إنما قصدي من ذكر هذه الأمور أن الدعاء لا يكون ذا تأثير ما لم يكن بين طالب الدعاء والداعي علاقة خاصة. فما لم تتولد في الداعي حالة الاضطرار، وما لم يصبح قلق الطالب قلق الداعي نفسِه، لا يجديه دعاؤه شيئا. فالمشكلة التي تواجه الناس أنهم يجهلون آداب طلب الدعاء، وحينما لا يرون فائدة واضحة للدعاء يسيئون بالله الظنون، فيجعلون حالهم يُرثى لها.
وأقول أخيرا: سواء أدعوتم بأنفسكم، أو طلبتم الدعاء من أحد، فلا بد لكم من أن تتحلوا بالطهارة والصفاء، وتطلبوا الاستقامة، وتخرّوا أمام الله تائبين. فهذه هي الاستقامة، وعندها ستحظون باستجابة الدعاء والحلاوة في الصلاة. “ذَلِكَ فَضْلُ الله يؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ” (الجمعة:4).
(المصدر: رسالة للمسيح الموعود عليه السلام حول وحدة الوجود، ترجمة ص 14-23)

